عرفت القارة الأفريقية أشكالا مختلفة من الاستعمار والاستغلال الغربي منذ قرون طويلة، بدأت مع عصور الاحتلال البرتغالي في القرن الخامس عشر وما بعده، حين شرع البرتغاليون في السيطرة على مناطق غرب أفريقيا واتخذوها مراكز لتجارة العبيد، واستغلّوها في أنشطتهم الاستعمارية سواء في أفريقيا أم في أميركا اللاتينية والوسطى.
وقد راجت هذه التجارة حتى توسع فيها الإسبان والهولنديون والأميركيون والفرنسيون والبريطانيون، وكل منهم كان يأخذ حاجته من “العبيد” الأفارقة لتنمية مناطقهم التي احتلوها في الأميركتين وغيرهما، واستمر ذلك حتى اكتفوا من هذه التجارة ومنعوها في القرن التاسع عشر.
تطورت العلاقات الأوروبية مع منطقة غرب أفريقيا على وجه التحديد تجاريًّا بصورة كبيرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، فكانت حركة البضائع بين الدول الأوروبية وشعوب هذه المنطقة في كل السلع تقريبا لا تكاد تتوقف، ولما لم يكن الأفارقة يتعاملون بالعُملات، كانت المقايضة هي سبيلهم في ذلك، وعلى رأسها المقايضة بالعبيد الذين احتاج إليهم الأوروبيون في مستعمراتهم المختلفة حول العالم.
يرصد المؤرخ البريطاني جون دونيلي فيج، أو “جي دي فيج” كما يُعرف، في كتابه “تاريخ غرب أفريقيا” طبيعة التطورات السياسية في هذه المنطقة وقتئذ، فمع ازدياد نفوذ الأوروبيين وحضورهم في المنطقة، أصبحت الأنظمة السياسية الأفريقية ضعيفة ومنقسمة وتعددت الإقطاعيات المتنافسة، وهو ما استغله الأوروبيون لحوز المزيد من النفوذ.
وفي غضون وقت قصير، بدأ التنافس الاستعماري بالظهور، وكما حدث في الهند بدأت الأمور بالتجارة وانتهت بالاستعمار، فتكررت تلك الدورة البغيضة بحذافيرها في غرب أفريقيا.
كانت تلك المنطقة البعيدة الممتدة جنوب الصحراء من نهر السنغال وجنوب مالي والنيجر شمالا مرورا بساحل العاج ونيجيريا وسيراليون وحتى غينيا وحدود أنغولا في الجنوب الغربي قد عرفت الإسلامَ في مراحل تاريخية متفرقة.
بدأت مع الفتوحات الأولى زمن عقبة بن نافع والأدارسة في المغرب الأقصى ثم الحركة الدعوية الكبرى التي قام بها المرابطون خلال القرن الخامس الهجري التي أثمرت وأينعت في هذه المناطق، فنشأت ممالك ودول إسلامية كبرى مثل مملكة مالي وبورنو وصُنغاي، كما قامت الحركات الصوفية المهمة مثل التجانية وغيرها بنشر الإسلام بين القبائل الوثنية الأفريقية بكل جدّ.
أحلام ساموري
وبحلول القرن التاسع عشر، وقعت حركة بعث إسلامي كبيرة في هذه المناطق بهدف إعادة أمجاد الممالك الإسلامية الكبيرة في مالي والسنغال ونيجيريا، وإعادة توحيد المسلمين والحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية، إضافة إلى زيادة نفوذهم السياسي وحضورهم الجغرافي.
وكان ساموري توري أحد الزعماء الأفارقة المسلمين الذين أدّوا دورًا مهما ومحوريا على مساحة قُدّرت بمليون كيلومتر في مناطق غرب أفريقيا، بين النيجر وجنوب مالي شمالا مرورا بساحل العاج وحتى غينيا كوناكري غربًا، ولا سيما قبل زمان الاستعمار الفرنسي لهذه المناطق وبعده.
وُلد ساموري توري عام 1835 في منطقة سانانكورو في وسط ما يُعرف اليوم بجمهورية غينيا كوناكري، لأسرة مسلمة فقيرة من قبائل المالنك، وقد عمل ساموري منذ صغره في الزراعة والتجارة متنقلا بين أهله وأقربائه؛ تارة تجده في مالي صغيرا وهو في سن السابعة يزرع ويشقى، وأخرى في سن البلوغ في الثمانية عشرة في ساحل العاج يحترف تجارة البارود والسلاح ويتخصص فيها.
وقد علّمته هذه التجارب الاعتماد على النفس، وعرّفته مصادر الحصول على الأموال والسلاح، وطبائع شعوب المنطقة، وكانت الحادثة التي غيّرت تفكيره هي وقوع أمّه في الأسر عام 1852؛ فعند سماعه هذه الخبر الأليم أخذ يفكر في أفضل الطرق لتخليص أمه، ولأنه كان لا يزال ضعيفًا قَبِل أن يعمل لدى خاطفي أمّه مدة سبع سنوات مقابل فكاكها.
كانت هذه السنوات السبع درسًا عظيمًا في حياته، فقد أدرك أن حماية المسلمين في هذه المناطق تتطلبُ أن يكونوا أقوياء ذوي نفوذ، وأن يكون لديهم دولة يحمون بها دينهم وأعراضهم من الغارات وممارسات النهب والتعدي.
وبداية من عام 1861 شرع في تعبئة المقاتلين من أبناء قومه، والدعوة إلى بناء دولة إسلامية، وقد نجح في هذه التعبئة، واستطاع الحصول على الأموال والسلاح الحديث من التجار الإنجليز في سيراليون، وفي فترة قصيرة أخذ نفوذه يتمدد في المناطق التي تشكّل اليوم وسط غينيا كوناكري.
بين عامي 1865 و1879 دخل ساموري في صدام مع قبائل المنطقة الوثنية بسبب تعديهم على المسلمين، وقطعهم طرق التجارة، فبدأ التجار الكبار يتعاطفون معه حتى غير المسلمين منهم، ورأوا أن الحاجة ضرورية لوجود دولة تحقق لهم الأمن وحرية التجارة في هذه المنطقة.
وبسبب النجاحات التي حققها، دخل في تحالف مع المسلمين في مدينة كانكان واستطاع أن يتقدم بقواته نحو أعالي النيجر، وبحلول عام 1880 صار قائد أكبر إمبراطورية إسلامية عرفها شعب المالنك على مساحة قدرها حوالي مليون كيلومتر تمتد من حدود النيجر ومالي إلى ساحل العاج، وغينيا وتخوم سيراليون وليبريا.
ومن أجل السيطرة المحكمة على هذه المساحات الشاسعة التي تضم اليوم أجزاء كبيرة من خمس دول في غرب أفريقيا، عمل على تقسيم دولته إلى 162 مقاطعة ضمن عشر إدارات مركزية يترأس كل واحد منها رجل من رجاله الثقات يعاونه في الحكم والإدارة، على أن يكون رجلا فقيها من رجالات الدين للفصل في المنازعات، وتحقيق العدل بين الناس، وتطبيق أحكام الشريعة.
الصدام مع الفرنسيين
لم تتجلَّ شخصية ساموري القيادية فقط في نجاحاته الميدانية، بل في قدرته على تذويب هذه العرقيات والقوميات والشعوب المتناحرة في دولته الناشئة بصورة لافتة، حتى إن الجنرال الإيطالي أورست باراتير أقرّ في أثناء دراسته لسيرة ساموري وتحركاته في غرب أفريقيا وهو معاصر له بأنه “أظهر تفوقًا على معظم زعماء القارة الأفريقية في القيادتين السياسية والعسكرية”، بل أقر أعداؤه الفرنسيون كذلك بهذه المهارات كما ترصد المؤرخة إلهام محمد علي في كتابها “جهاد الممالك الإسلامية في غرب أفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي”.
وقد دفعه طموحه والنجاحات التي حققها إلى مزيد من التوسع في نشر الإسلام نحو المناطق الاستوائية والصحراوية المتفرقة لا سيما بين القبائل القريبة في ساحل العاج وغينيا والنيجر.
ولكن ذلك الطموح تزامن مع توسع الاستعمار الفرنسي في غرب القارة الأفريقية بداية من عام 1842، حيث نجح الفرنسيون في توقيع اتفاقيات حماية مع كثير من الزعماء المحليين، وكانت هذه حجتهم للانطلاق لاحتلال مجرى نهر النيجر الأعلى بما في ذلك مالي، وأصبح الصدام بين ساموري توري وبين الفرنسيين حتميًّا وقريبا.
ففي عام 1881 رفض ساموري الانسحاب من منطقة كان يسيطر عليها في غرب أفريقيا لصالح فرنسا، وهو ما أدى إلى اندلاع العديد من المعارك بين الجانبين استطاع ساموري أن ينتصر في كثير منها، ولكن الفرنسيين شرعوا في تكوين تحالفات مع القبائل الوثنية في المنطقة، وأدت هذه التحالفات الجديدة إلى توسع دائرة القتال بين الجانبين طوال السنوات التالية.
وفي العام التالي (1882)، أراد الفرنسيون تلقين ساموري درسًا قاسيًا ومنعه من الإغارة على البلاد المجاورة وتأكيد السيطرة الفرنسية على المنطقة الممتدة من السنغال إلى النيجر التي وُجدوا فيها بقوة، وكان ساموري يقطع هذا الطريق في بعض مناطقه، والتقى الفريقان في معركة قادها فابو أخو ساموري، الذي نجح في إلحاق الهزيمة بالفرنسيين في 2 مارس/آذار 1882؛ مما اضطر قائد الحملة الفرنسي ديبورد إلى الانسحاب.
وكان الاتصال التالي بين الفريقين بعد عام واحد بعد أن تمكن القائد الفرنسي ديبورد من توطيد مركزه في النيجر وقد فوجئ بقدوم فابو وقوات ساموري للانقضاض على القوات الفرنسية المستعمرة للمنطقة، وقد نجحت من جديد قوات ساموري في طرد الفرنسيين.
توالت المعارك بين الجانبين، وفي كل مرة كان ساموري يدرك مدى قوة الفرنسيين وتقدمهم التقني والعسكري مقارنة ببنادقه القديمة؛ ولهذا السبب آثر بقدر الإمكان عقد اتفاقيات معهم بُغية تجنب الحرب، وترك لهم بعض المناطق التي كان يسيطر عليها ريثما يقوِّي نفوذه وجيشه وتحالفاته الداخلية، فكان يستغل التناقضات بين الفرنسيين والإنجليز في استعمار المنطقة، ويشتري من التجار البريطانيين في سيراليون البنادق السريعة الطلقات، التي أثرت بشكل كبير في المعارك، إلى درجة جعلت فرنسا ترسل العديد من مذكرات الاحتجاج إلى وزارة الخارجية البريطانية عامي 1890 و1891.
في المقابل لم يترك الفرنسيون لساموري منفذا لدعم قوته، وتوسيع رقعته؛ حيث بدؤوا التدخل في شؤون دولته وتحريض أتباعه عليه، بل والهجوم على أهم المدن التي كان يسيطر عليها واحتلالها ولا سيما في غينيا، ولكل هذه الأسباب اضطر ساموري إلى قيادة قواته العسكرية لمواجهة الفرنسيين، وجرت بين الجانبين معارك بين عامي 1888 و1890، وتمكن من إعادة سلطته على جميع أنحاء مملكته، غير أنه أدرك أن الفرنسيين لن يسمحوا له بالإصلاحات الداخلية التي كان يريدها، ولا سيما تحديث قواته ومعداته.
أفول ساموري وعلو نجم حفيده!
خلال الحقبة التالية، الممتدة بين عامي 1891 و1898، لم تهدأ المعارك الحربية بين الجانبين سواء في مناطق النيجر أم في مناطق غينيا الغربية، وأدرك الفرنسيون أن قيام دولة على أُسس من الشريعة والإسلام يناقض طموحاتهم الاستعمارية والتبشيرية في المنطقة، وكان ساموري في أثناء هذه المرحلة الأخيرة والصعبة من النضال يضطر كل حين إلى استيراد الأسلحة الحديثة من سيراليون وليبيريا، وكما يقول محمد فاضل وسعيد إبراهيم في كتابِهما “المسلمون في غرب أفريقيا” فإن “أمير المؤمنين” ساموري توري قرر تقسيم قواته إلى ثلاث فرق؛ لمواجهة قوة المدافع الفرنسية التي كانت تخترق تحصينات جيشه.
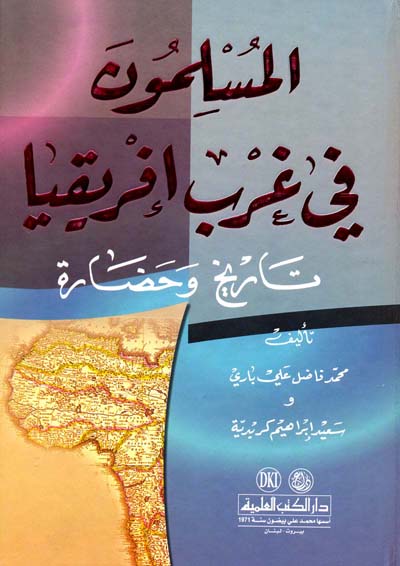
فأما الفرقة الأولى فقد أمرها بالتوسع شرقًا وضمّ أراضٍ جديدة تعويضًا عن الأراضي التي فقدها أمام الفرنسيين في الغرب، وأما الفرقة الثانية من القوات فكانت تتمركز في مناطق ساحل العاج وغانا، وأما الفرقة الثالثة فتخصصت حصرًا في مقاتلة الفرنسيين وتكبيدهم أعلى قدر ممكن من الخسائر في الرجال والمعدات، وكان ساموري يتبع في مواجهته مع الفرنسية سياسة الكر والفر، وسياسة “الأرض المحروقة” إذا شعر بأنهم سيستولون على المدن أو القرى التي يسيطر عليها.
وفي نهاية المطاف وبعد حروب طاحنة نجح الفرنسيون في احتلال العاصمة كانكان التي تقع اليوم في غينيا؛ فاضطر ساموري إلى نقل عاصمته إلى مدينة دايكالا التي تقع في ساحل العاج، وذلك عام 1895، كما حاول اتخاذ إستراتيجية جديدة بجوار المقاومة العسكرية التي أشعلها ضد الفرنسيين منذ عام 1881، وهي سياسة المراوغة الدبلوماسية والسياسية.
إذ أدرك ساموري وجود الاستعمار البريطاني ومصالحه في غرب القارة الأفريقية لا سيما في ليبيريا ونيجيريا وسيراليون وساحل العاج، وقد حاول اللعب على التناقض السياسي والاستعماري بين الدولتين، ولكنه أدرك متأخرا أن الفرنسيين والإنجليز اتفقوا على احترام كل منهم لنفوذ الآخر، وذلك في مؤتمر برلين للدول الاستعمارية بعد احتلال إنجلترا لمصر سنة 1882؛ مما يعني فعليا تقسيم مناطق النفوذ الأفريقية بين القوتين الاستعماريتين.
بل إن البريطانيين أنفسهم أصبحوا يضيقون ذرعًا بساموري وقواته لأنه بدأ الانتقال إلى الأراضي الداخلية لساحل العاج وهي جزء من المستعمرات البريطانية المزعومة، وأصبحت الجرائد البريطانية في لندن وسيراليون تكتب وتتابع تقدم قوات ساموري وخطورتها في مناطق النفوذ البريطاني في غرب أفريقيا؛ ولهذا السبب قررت لندن أن تمنع تزويده بالسلاح، وأن تتعاون مع الفرنسيين عليه.
وحين فشل في اللعب على التناقض بين القوتين الاستعماريتين آثرَ ساموري أن يعقد هدنة جديدة مع الفرنسيين ليعيد تنشيط قوته، وتوسيع مساحته في منطقة الغابات الاستوائية. وقد تظاهرَ الفرنسيون بعقد هدنة سلام معه، ولكنهم كانوا يضمرون له التآمر والخديعة، ويعملون على تدمير دولته وقواته.
إذ استغل الفرنسيون انطلاق ساموري وكثير من قواته لفتح المناطق الاستوائية في مَواسم الأمطار، فعملوا على محاصرته بصحبة القبائل المتحالفة معهم في غابات ساحل العاج بعد أن منعته بريطانيا من التقدم شرقا ناحية غانا. وأمام هذا الحصار المطبق اضطر ساموري وقواته إلى البقاء في الغابات دون خُطة مسبقة وسرعان ما ضربهم الجوع، فاضطر أغلب جيشه إلى الانفضاض عنه، ولما علم الفرنسيون بهذه المستجدات شدّدوا محاصرته.
وهكذا وبعد اتحاد البريطانيين والفرنسيين، تمكن الفرنسيون من القبض على ساموري في غابات بوركينا فاسو، وذلك في 29 سبتمبر/أيلول 1898، وتم ترحيله إلى الغابون ووضعه في سجونها حتى لقي ربّه هناك عام 1900.
وقد رفع راية المقاومة من بعده حفيده أحمد سيكو توري (1922 – 1984) الذي تمكّن هو ورفاقه من المقاومين من الشعب الغيني أن ينالوا استقلال بلادهم من الفرنسيين عام 1958 قبل كل المستعمرات الفرنسية الأخرى في غرب أفريقيا، وانتُخب أول رئيس لجمهورية غينيا كوناكري بعد الاستقلال.














