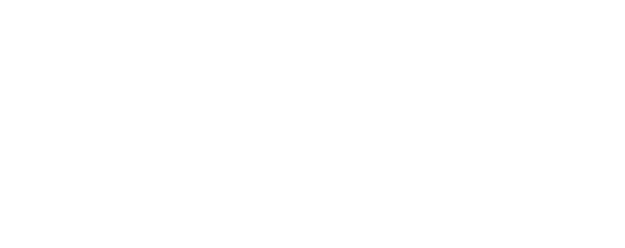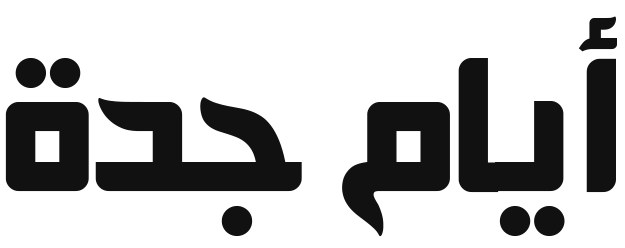يتميز الشعر الغنائي بشدة اقترانه وارتباطه بذات الشاعر، وبما يتعرض له من مواقف في الحياة، وما يكوّنه من علاقات وصِلات إنسانية، فهناك رابطة قوية في الشعر الغنائي بين الشاعر وقصيدته وخلفياتها أو مثيراتها بالمعنى السيري-الحياتي، ذلك أن “بذرة الموضوع في الشعر الغنائي هي التحليل الأخير لمواقف حياتية معينة، وتلك حقيقة لا تقبل الجدل، وتصل حدا من الصدق أفضى أكثر من مرة إلى محاولة إعادة بناء علائق واقعية مباشرة بين المبدع ومن يحيطون به من البشر في ضوء شعره الغنائي”.
وتبعا لهذه الروح التي تتأسس عليها القصيدة الغنائية، فإن معظم سماتها تنبع من تلك الذاتية وتترجمها على نحو أمين، من خلال ارتكازها غالبا على ضمير المتكلم المفرد، فهو الضمير الذي يقابلنا في معظم القصائد الغنائية، وهو يعبر مباشرة عن صوت الشاعر الذي يتكلم بلسانه ويعبر عن ذاته، كما لو كان لا يتوجه إلى أحد في خطابه، إنه -بتعبير إليوت- “صوت الشاعر مخاطبا نفسه، أو غير موجه كلامه إلى أحد”.
اقرأ أيضا
list of 2 items
الفلسفة في خدمة الدراما.. استلهام أسطورة سيزيف بين كامو والسينما المصرية
“مذاقات الموت والركام”.. الروائي الغزي عبد الله تايه: لا لغة تصف فواجع الحرب
end of list
وقد نبه يوري لوتمان إلى أهمية الضمائر في الشعر الغنائي قائلا: “أما في الشعر الغنائي، فإن جميع الشخصيات الغنائية تتوزع طبقا لنظام الضمائر إلى الضمير الأول (المتكلم) والضمير الثاني (المخاطب)، والضمير الثالث (الغائب)، وحين نقيم أنماط الصلات والعلائق بين هذه المحاور الدلالية فيمكن أن نحصل على الموضوعات الأساسية في الشعر الغنائي. كما أن طرز الموضوعات التي نحصل عليها بهذه الكيفية تكون ذات طابع تجريدي بوجه عام”.
التقسيم المقطعي في القصيدة الغنائية
وكثيرا ما تعتمد القصيدة الغنائية -مع ميلها إلى القصر والكثافة- على نظام التقسيم إلى مقاطع، بحيث يشكل المقطع اندفاعة عاطفية مختزلة، “إن أشد الوحدات طبيعية في القصيدة الغنائية هو المقطع الذي يشكل وحدة منفصلة. وكانت معظم القصائد الغنائية في العصور السالفة تنحو إلى الانتظام في أنساقها المقطعية، عاكسة بذلك أهمية الخطاب”.
كما تشتهر القصيدة الغنائية بارتباطها المتين بالموسيقى وبالإيقاع، ذلك “أن ارتباطات الشعر الغنائي هي بالدرجة الأولى مع الموسيقى. فقد تحدث اليونانيون عن القصائد الغنائية بوصفها قصائد للغناء “ta mele”. أما في عصر النهضة فقد ارتبطت القصائد الغنائية بالقيثارة أو العود، وشدد ‘بو’ على أهمية الموسيقى في الشعر بوصفها عنصرا يعطي له من القوة ما يفتقر إليه من حيث الدقة.
لكن يجب أن لا ننسى أن القصيدة عندما تغنى -بالمعنى الموسيقي الحديث على الأقل- فإن نظامها الإيقاعي تستولي عليه الموسيقى…، نحصل على انطباع أفضل عن القصيدة الغنائية إذا ما ترجمنا “ta mele” بقصائد للتنغيم، لأن التنغيم يعني التأكيد على الكلمات بوصفها كلمات. والشعراء المحدثون الذين يريدون أن تنغم قصائدهم كثيرا ما يكونون أقل ثقة بجدوى تلحينها”.
إعلان
كما يؤكد النقاد على التكوين التصويري والتخييلي في القصيدة الغنائية، وشدة ارتباطه بالمحتوى العاطفي والوجداني لها، وهي خصيصة معروفة لهذه القصيدة، وامتدادا لأهمية الصور في الشعر الغنائي تنشأ ظاهرة “مزج المجسد والمجرد…، فكل الصور الشعرية تقوم فيما يبدو على الاستعارة…، تعطي القصيدة الغنائية أهمية خاصة للاستعارة المدهشة غير المتوقعة التي تدعى التعسف المجازي (catachresis)، والقصيدة الغنائية تعتمد أكثر من أي نوع أدبي آخر على الصورة الطازجة أو المدهشة للوصول إلى ما تبتغيه من تأثير، وهذه حقيقة غالبا ما توهمنا بأن هذه الصور جديدة تماما أو غير تقليدية. لقد ظلت البؤرة العاطفية في القصيدة الغنائية تعتمد على هذا الومض المفاجئ للاستعارة الملتحمة”.
الخصائص العامة للشعر الغنائي
وقد اجتهد صبحي حديدي في تلخيص أبرز ما جرى الاتفاق عليه بشأن الخصائص التي تميز الغنائية، من مثل:
- أنها إجمالا قصيرة أو قصيرة نسبيا. وما يضفي خصوصية تعبيرية على القصيدة الغنائية ليس الإيجاز اللفظي، بل هو إيجاز التجربة الإنسانية التي تلتقطها تلك القصيدة.
- الصوت الناطق في القصيدة الغنائية يعود إلى ضمير المتكلم، بصيغة المفرد أساسا. وإذا توفرت صلات حوارية بين هذا الصوت والضمائر الأخرى فإن تلك الصلات تنبثق من الداخل إلى الخارج، أي من ضمير المتكلم إلى الضمائر الأخرى.
- هيمنة ضمير المتكلم المفرد على حركة القصيدة تحرض على نشوء بؤرة تركيز للعلاقة بين الشاعر والقارئ، وتخلق مساحة مشرعة يشغلها هذا الأخير في تفاعله مع القيم الوجدانية والشعورية والعقلية التي يتوسلها الشاعر.
- القصيدة الغنائية شخصية في موضوعها، وذاتية في التقاطها للعالم الخارجي، ومتخففة وأحيانا خالية من البنية الدرامية والخط السردي.
- القصيدة الغنائية عالية التركيز في طرائقها التعبيرية، لأن حجم أي نص يلعب دورا بارزا في صياغة بنيته ومحتواه، ولأن البرهة الكثيفة الملتقطة على مستوى المعنى لا بد أن تستدعي كثافة نظيرة على مستوى الشكل أيضا. ومعمار القصيدة الغنائية الإيقاعي يتطلب التركيز العالي والإشارة البرقية وهندسة التكرار المقطعي أو الصرفي أو اللفظي، وهذا النمط أو ذاك من اللازمة التي تشد نسيج الإيقاع.
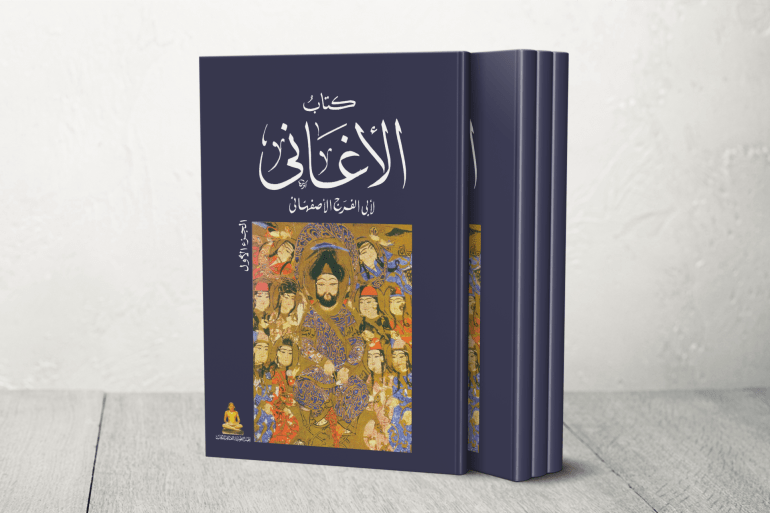
الشعر الغنائي في التراث العربي
ويمثل الشعر الغنائي نمطا أصيلا في تاريخ الشعر العربي، بل يكاد يكون النوع الأساسي في تراثنا الشعري، فالشاعر العربي ينطلق من ذاته وينطق بصوته، وتشكل العاطفة والمحتوى الوجداني البطانة الأساسية التي تميز الشعر العربي بمختلف أغراضه، فضلا عما بلغه الشعر العربي من عناية عالية بالإيقاع المنظم، والالتزام بالتقفية، وغير ذلك من التزامات موسيقية فارقة.
إعلان
بل نجد هذا الشعر صالحا للغناء، حتى أمكن ذلك أبا الفرج الأصفهاني من وضع كتابه الشهير (الأغاني) استنادا إلى الشعر المغنى. ويتأكد هذا الانتماء للشعر الغنائي بارتباط الشعر العربي بالإنشاد والأداء الشفوي والتجويد في الإلقاء، بما يقرب من التنغيم ومن استكمال المعنى وإشباع الدلالة عبر هذه الظواهر الأدائية التي ترتبط بصوت مؤد منفرد، ينطق بصوته الخاص ويكشف عن رؤيته لما حوله.
من الغنائية إلى الدرامية
تعود “الدراما في أصولها اللغوية إلى كلمة “dram”، وهي كلمة يونانية قديمة تعني حرفيا: يؤدي عملا، كما تعني أيضا الحدث أو العمل الذي يؤدى. وقد انتقلت هذه الكلمة من اليونانية القديمة إلى سائر اللغات الأوروبية لتغدو “drama”، ثم عربت وأصبحت تنطق في العربية على النحو نفسه: دراما.
وقد شهد الشعر العربي الحديث ضربا من الانفتاح على التوجهات الدرامية منذ تجارب الرواد، ذلك أن الموضوعات الجديدة للشعر وانفتاح الشاعر على نماذج من الشعر العالمي وضرورات التجديد شكلت تحديا للإطار الشعري الغنائي، وضرورة توسيعه، وكانت إحدى نوافذ التجديد والتحديث تطوير أنماط جديدة تصل الغنائي بالدرامي والملحمي، لا من خلال تكرار الأشكال القديمة لهذه الأنواع الشعرية، وإنما من خلال قصيدة حديثة تفيد من بعض خصائص هذه الأنواع بما يسمح بإنتاج قصيدة تستجيب لرؤيتها الجديدة ومضمونها الحديث.
وقد لاحظ عز الدين إسماعيل هذا التطور “من الغنائية الصرف إلى (الغنائية الفكرية)، وصارت أروع القصائد الحديثة العالمية هي أولا وقبل كل شيء قصائد ذات طابع درامي من الطراز الأول”. ورأى أنه ليس من السهل أن يتحقق الطابع الدرامي في الشعر “ما لم يتمثل وراءه أو فيه العناصر الأساسية التي لا تتحقق الدراما بدونها: الإنسان، والصراع، وتناقضات الحياة…، هذه هي العناصر الأساسية لكل قصيدة لها هذا الطابع الدرامي”.
إعلان
وهناك جملة من الخصائص الدرامية بيّن “داوسن” أهمها، منها: “مسألة التوتر الدرامي”، وهي “كلمة لا بد من أن تتكرر في كل حديث عن الدراما، فنحن بالطبع نتحدث عن موقف متوتر عندما نرغب في الإعراب عن الإحساس بأن حالة ما قد تتحول في أي لحظة إلى شيء متأزم مختلف…، إن أي عمل فني يمكن إدراكه بفهم العلائق المتداخلة بين أجزائه، وفي الدراما تكون العلاقة المتميزة بين الأجزاء علاقة توتر”.
فالتوتر يتأتى في الدراما من خلال تحولات سردية تصل إلى نقاط من التعقد والتأزم، نتيجة للصراع الذي تصوره الدراما، ويترافق مع هذا التوتر ضروب من الحركة والتشويق، “والتشويق لا ينفصل عن الدراما، وهو كثيرا ما يتخذ أشكالا ماكرة…، كل أنواع الهزل تخلق تشويقا…، ومن الوسائل البسيطة الأخرى لخلق التوتر الدرامي: المفاجأة: دخول عنصر جديد على حين غرة في موقف قائم، بحيث تتغير صورته مباشرة”.
كما عرض “داوسن” للسخرية الدرامية، بوصفها “نبرة صوت…، والنبرة للدرامي مورد ضروري وحتمي، إذ من الممكن للروائي (وللشاعر الدرامي) أن يستغل الكثير من تدرجات متناهية اللطافة في التوجه إلى القارئ مباشرة، وبين العرض الدرامي الذي يمكن القاص من الانسحاب كليا من عرضة الأحداث، أما الدرامي فلا يمكنه ذلك.
ثمة طرق مختلفة يستطيع الدرامي التوسل بها للالتفاف حول هذه المشكلة، كالمقدمات التمهيدية والخواتيم واستخدام (الكورس) وغير ذلك. فالدرامي قادر فعلا على إيراد لغة ساخرة على لسان أحد شخوصه”.
ويمكن القول إن الدرامية تعني عند الشاعر الحديث محاولة تخفيف الغنائية والتخلص النسبي من الصوت المنفرد، وتوسيع مساحة واسعة للشخصيات الأخرى كي تتقدم وتكشف عن صوتها بقدر من الموضوعية والاستقلال النسبي، فهذا بعض ما يمكن أن يصنع موقفا دراميا يوصل المعنى بطريقة مختلفة عن الطريقة التصويرية والعاطفية المرتبطة بالأنا في الحالة الغنائية.
إعلان
لقد سلك الروائيون والقصاصون هذا السبيل، والرواية إجمالا تميل أن تكون نوعا غير غنائي، ولكن طبيعتها التي تنفتح على العالم ويمكن عزلها أو إبعادها عن الذات تمكنها من ممارسة هذه الموضوعية الدرامية بكفاءة. ويبدو أن الشاعر الحديث نحا هذا المنحى في اتجاهه الدرامي، وليس الكلام عن تبريد اللغة الشعرية ومقاومة الحنين -وهو تعبير تردد مرارا على لسان الشاعر الراحل عز الدين المناصرة- إلا لونا من ألوان هذه الموضوعية للانتقال من الغنائية إلى الدرامية.
وقد لاحظ أحمد كريم بلال أن الدرامية تنهض بدور حيوي في تقليص الغنائية، ذلك أن “كفكفة الذات عن الهيمنة على المشهد الشعري الكلي للقصيدة هي صورة من صور النزوع إلى الدرامية، غير أن ثمة تقنيات درامية كثيرة تقدمها القصيدة العربية المعاصرة تستخدم لتقليص الغنائية أغلبها مستعار من المسرح، ذلك المنبع الدرامي الأصيل، ومن ثم لا يغيب مع هذا التوجه الدرامي تقديم القصيدة لمجموعة من الأحداث المأسوية التي تنتج عن صراع بين إرادتين، أو تقديم الحوار بكل تقنياته وأشكاله من خلال تقمص الشاعر لشخصيات متعددة وتعبيره عن انفعالاتها الخاصة، ومن ثم تتعدد الأصوات في القصيدة الواحدة، وقد تتناقض الرؤى والأفكار التي يعكسها كل صوت من هذه الأصوات”.
ويبدو أن أبرز ما تستدعيه القصيدة ذات النزوع الدرامي يرتبط بمزيج من العناصر القصصية والمسرحية التي يجري توظيفها بطريقة سردية تجعل من تجربة القصيدة تجربة موضوعية، من مثل: حضور وظيفة الراوي، وبروز الحدث، والصراع، والحبكة السردية، والحركة، والتوتر، والخصائص السردية، وتعدد الأصوات، وبروز الشخصية، وتوظيف القناع، والحوار، والمونولوج، والكورس (الجوقة)، وغير ذلك من عناصر ذات صلة.
يمكن التوجه الدرامي الشاعر من استعارة وجوه سردية ومسرحية متعددة تنفتح على عالم مختلف متعدد الأصوات والشهادات بما فيها شهادة الذات نفسها، إنها ليست مفاضلة بين أصوات الشعر الثلاثة بقدر ما هي بيان لإمكاناتها بعدما تطورت من أصولها القديمة إلى أشكال حديثة.
إعلان
ويبدو أن كتابة قصيدة درامية، في عصرنا، لا تتطلب صياغتها بصورة مسرحية ناجزة أو كاملة الشروط، بل يمكن التوصل إلى ذلك من خلال استعارة بعض توجهات الدراما، خصوصا مسألة تنوع الشخصيات وتعدد أصواتها، وكذلك بعض التقنيات التي تجعل الأفق أبعد وأوسع من إمكانات الصوت الواحد. ومن هنا ستحل في القصيدة روح سردية، تمكن عدة شخصيات من لعب أدوار وتمثيل مناطق أخرى، توسع من تجربة الذات، باتجاه الموضوع، فلا يعود مقصورا أو محبوسا في إطارها وحدودها.
الغنائية والدرامية في نماذج من الشعر الفلسطيني
يمكن الانتباه إلى تحولات الحياة الفلسطينية، وإلى صور من التراجيديا (المأساة) التي عصفت بتلك الحياة على مختلف الصعد، فأنتج ذلك ظواهر معقدة، مثلما تطلب معالجة شعرية مختلفة، أدت إلى الإسهام في تطوير الشعر بصيغته الغنائية، وذلك من خلال استنهاض طاقات القصيدة ودفعها إلى مناطق قصوى ليمكنها التعبير عن تلك الحالات والمواقف والأحداث المؤثرة المرتبطة بما ترتب على احتلال فلسطين وتهجير أبنائها، وما صاحب الثورة الفلسطينية المعاصرة من صعود وهبوط، وآمال وآلام، فذلك كله تطلب الخروج أحيانا من أسر القصيدة الغنائية للوصول إلى صيغ شعرية جديدة تستجيب لاتساع المعاناة ولما هو أوسع مما يقع ضمن إمكانات الصوت الغنائي وحدوده.
ويمكن أن نستجلي التحول من الغنائية إلى الدرامية عند عدد من الشعراء الفلسطينيين البارزين ممن لجؤوا إلى ضروب من الخصائص الدرامية، دون أن يتخلوا عن الغنائية تخليا تاما، وهذا ما يؤكد أن الدرامية الشعرية درامية متحولة ومنتقاة، جاءت لإثراء الشعر الغنائي ولتوسيع آفاقه، وليس للتخلص منه، أو هجرته إلى نوع جديد، ذلك أن الغنائية ضاربة الجذور في الشعر العربي ويصعب النظر إليها بهذه الصورة الحادة من التحول أو الانتقال.
إعلان
أما الشعراء الذين نتناول صورا من الدراما في شعرهم فهم: معين بسيسو، محمود درويش، عز الدين المناصرة، وليد سيف. مع التأكيد أن هذا المنحى من جدل الغنائية والدرامية اتجاه يكاد يظهر بصور متفاوتة في إنتاج معظم الشعراء الفلسطينيين المعاصرين، ويمثل خصيصة كبرى من خصائص الشعر العربي الحديث بأسره.
-
أولا: معين بسيسو
قد يكون معين بسيسو (1927-1984) من أهم الأصوات الشعرية التي تنبهت إلى إمكانات الدراما مبكرا، ويعود ذلك إلى اهتمامه بالمسرح والشعر المسرحي، إلى جانب تجربته الشعرية المعتبرة، ونتيجة لهذه الخبرة فقد أفاد من وعيه المسرحي في تجويد شعره وتطويره، ومن آيات ذلك توظيفه لشخصيات صريحة مرتبطة بالمسرح، كما في قصيدة (يوميات ملقن مسرح)، ومركز القصيدة هذه الشخصية المسرحية التي تدل على وظيفة هامشية في عالم المسرح، لكن الشاعر استثمر هامشيتها ليطلق لها حرية القول في قصيدة تامة. وأما لفظة “يوميات” فتعني ضربا من تسجيل التفاصيل اليومية، وهي تحيل إلى أنواع الأدب الشخصي كالسيرة والمذكرات، ولا يخفى ما تشير إليه من الطبيعة السردية.
بنى معين بسيسو القصيدة على مبدأ “اليوميات”، ليكون مرتكز بناء القصيدة وصاحب اليوميات ليس الشاعر، وإنما “ملقن المسرح”، أي شخصية مستقلة عن الشاعر لها طبيعتها الموضوعية، ولها بناؤها وصراعها الناشئ عن تلك الهامشية، فهي شخصية قريبة من المسرح وبعيدة عنه في آن واحد، تتواصل مع الممثلين وتساعدهم دون أن ترقى للانضمام إليهم، فخصص الشاعر فقرة شعرية لكل يوم من أيام “الملقن”، وكلها يوميات للشخصية المختارة، ملقن المسرح، وهو شخصية معروفة للعاملين في المسرح، شخصية هامشية لا تظهر أمام الجمهور على المسرح، ولكنه يتابع أداء الممثلين وإتقانهم للنص، وإذا ما نسي الممثل دوره ساعده الملقن بالجملة المنسية من وراء الستار. استيحاء الشخصية بالتأكيد جاء إلى عالم معين بسيسو من واقع خبرته بالمسرح، فهو مسرحي إلى جانب تجربته الشعرية.
إعلان
يقدم الملقن في يومياته بعض تفاصيل عالم المسرح وشخصياته من زاويته الخاصة، كما يتذكر شخصيات مسرحية شهيرة (كهاملت)، ويذكر ممثلة ثانوية أحبها ثم اشتهرت وتركته. يتمرد أخيرا على وظيفته ولا يلقن الممثل دوره فيطرد في النهاية، ولكنه يحقق خلاصه وحريته من خلال الخروج على الدور المرسوم المقيد له.
نحن إزاء قصيدة لا يحضر فيها صوت الشاعر الذي نلتقيه في الشعر الغنائي، بل صوت شخصية غدت رئيسية ومركزية (في القصيدة) خلافا لأصلها المسرحي الهامشي، مقابل تهميش شخصيات الممثلين، كل ذلك دون أن يغدو النص ضربا من المسرح، فنحن إزاء سمة درامية أصيلة في قصيدة من قصائد الشعر الحديث.
ولمعين بسيسو بصمات أخرى، منها ما عمد إليه في بناء القصيدة مستفيدا من تقنيات مسرحية مختارة، أي توظيف التقنيات المسرحية في بناء القصيدة، ويمكن التمثيل عليها بـ”قصيدة من فصل واحد”، والمعلوم أو المتوقع أن تكون مسرحية من فصل واحد، وهي الجملة التي عدلها الشاعر ليكتب “قصيدة من فصل واحد”، وعندما نتأمل هذه القصيدة نجدها قد استندت حقا إلى عدد من التقنيات المسرحية، منها:
“يا رفيقي في السلاح والقصيده
يجيء الآن ألف انتهازي مُزركَش
وألفُ كذّاب مرقّع
أين كانوا
نحن مَن حملنا في زمان القحط والجرادْ
في ليالي الارتدادْ
في جهنم الزنزانة القديمة الجديدة
بطاقة الثورة والحزب والقصيدة
تنكرنا العواصم
تخونُنا الخواتمُ
إلى مساوم
يبيعنا مساومُ”– معين بسيسو pic.twitter.com/qzU3WjGkWx
– أحمد عطا ☭ (@AhmedaT22238584) March 16, 2024
بناء القصيدة في “مناظر” أو “مشاهد” مستوحاة من البناء المسرحي، وطريقة تقطيع الأعمال المسرحية، فهي مبنية في سبعة مناظر، شأنها شأن المسرحية، (المنظر الأول، المنظر الثاني… إلخ) وفي ختامها عبارة “ستار”، وهي أيضا من لوازم الكتابة المسرحية، كتوجيه للمخرج وللممثلين في نهايات المشاهد أو المسرحية ككل.
إعلان
وكل منظر له عنوان فرعي يمثل الصوت الناطق أو المتحدث فيه، المنظر الأول يحضر فيه صوت “الجوقة” أو ما يسمى “الكورس”.
والمنظر الثاني على لسان “الشاعر على الربابة”. أما صوت الشاعر نفسه فلا وجود له، وإنما يعبر الشاعر عما يريد بما يقع ضمن تسمية التعبير الموضوعي، أي من خلال مجمل الشخصيات التي تنتقد أوضاع العالم العربي وواقعه قديما وحديثا، وتدور في فلك الأفكار الثورية والوطنية التي يتبناها معين بسيسو.
ومثال آخر من عالم معين بسيسو مما يمثل اقتراب بناء القصيدة من بناء المسرحية بشكل صريح وعلني، قصيدة “مأساة الدب مراد”(17) أيضا، وتعتمد على شخصية “المهرج”، وهي أيضا شخصية مسرحية مما يقرب من الهامش ويعبر عنه المهرج الذي يؤدي دور “الدب مراد” ويحمل اسمه أثناء تعرضه للتحقيق، وفكرة التحقيق تربطنا بالتحديات والمشكلات الأمنية التي طالما تعرضت لها الشخصيات الفلسطينية، وهي الفكرة المركزية في بناء الحوار بين المحقق والدب مراد أو المهرج.
تبدأ المسرحية بصوت الجوقة، ثم يبدأ التحقيق. وفي القصيدة تقنية “المونولوج المسرحي” الذي يحدث فيه الممثل نفسه على المسرح بصوت مسموع يصل إلى الجمهور، خلافا للمونولوج السردي الذي يكون صامتا ومعبرا عن تفكير الشخصية وعالمها الداخلي.
وتنتهي بـ”ستار” ليكون ختامها أيضا بالتوقيع الدرامي المسرحي. وهذه إجمالا قصائد قصيرة، تعتمد على الحوارات، واللغة فيها لغة شعرية من ناحية إيقاعاتها وتراكيبها، ولا تبلغ المسرح الشعري المعروف في عالم بسيسو وغيره من الشعراء، فهي صورة من صور توظيف تقنيات المسرح في الشعر أكثر منها كتابة مسرحيات شعرية.
-
ثانيا: محمود درويش
يمثل محمود درويش (1941-2008) الصورة العليا للغنائية في العصر الحديث وفق كثير من القراء والنقاد، فهو شاعر غنائي آسر، بموسيقاه وبصوته الطاغي المتفجر داخل قصيدته، ولكنه لم يقصر شعره على ما نعرفه من غنائيته، بل اجتهد في بعض مراحل تجربته في التخفيف من غلواء الغنائية، عبر ضبطها وتضييق مساحتها، فعمد إلى بعض التجارب الدرامية المبكرة التي أدت إلى إطالة القصيدة واتجاه الشاعر إلى ضرب من المطولات، مثل:
إعلان
قصيدة “سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا”، وقصيدة “الأرض”، وقصيدة “أحمد الزعتر”، وقصيدة “جندي يحلم بالزنابق البيضاء”، وصولا إلى مراحل أشد تعقيدا في قصائد لاحقة، مثل: “خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة أمام الرجل الأبيض”، وديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا؟”، وقصائد الأقنعة في دواوينه الأخيرة، إلى جانب قصيدة “طباق” المتعلقة بشخصية حقيقية هي شخصية المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد وغيرها الكثير.
طوّر درويش طريقة خاصة في بناء القصيدة التي تتمحور حول شخصية مختارة لها مساس أو أثر في الحياة الفلسطينية، كأن يكون بطلا أو شهيدا أو نحو ذلك، وكثيرا ما يعمد إلى تجاوز الحدود الواقعية للشخصية نحو أسطرتها وترميزها للالتحام بالمأمول من تطلعات الإنسان الفلسطيني.
كما طوّر أساليبه للاستعانة بالحوار في كثير من قصائده، ولعل الحوار عنصر رئيسي على سبيل المثال في عمله المعروف “لماذا تركت الحصان وحيدا؟”، فهو يتحاور مع نفسه ومع والده ومع جده ومع أمه، فيما يشبه تأمل السيرة الذاتية برؤية موسعة، تجعل منها سيرة فلسطينية منفية، مثلما يحاور أو يجادل المحتلين والأعداء.
وهذا الحوار مع الآخر/العدو إحدى خصائص شعر درويش الموضوعية، التي اقتضت منه أن يكون دراميا في هذا المنحى، ذلك أن الصراع المتصاعد والمتأزم من خصوصيات الدراما التي يمكنها التعبير عنها بأفق مفتوح.
إن قصيدة “جندي يحلم بالزنابق البيضاء” هي قصيدة درامية بما ترصده من حركة وصراع داخل نفس الجندي الصهيوني الذي يقرر أخيرا أن يتخلى عن بندقيته، ويترك الحرب والمتحاربين.
ولقد تبيّن مؤخرا أنه حقا كان هناك جندي واقعي وليس متخيلا استند درويش إلى قصته ممثلا الخيار الذي آل إليه، وأنه ليس إلا المؤرخ والكاتب “شلومو ساند” الذي تخلى عن الصهيونية وتحول إلى نقدها وكتب أكثر من كتاب أشهرها “اختراع الشعب اليهودي”.
إعلان
يهمنا هنا أن القصيدة لم تجد أفضل من المنحى الدرامي للتعبير الشعري المختلط بالسرد الصراعي الحواري، وليس صوت الشاعر في مثل هذا الحال إلا أحد خيوط الصراع.
تحضر في درامية درويش خصائص سردية مركبة، وتندمج بالإطار الشعري المتنامي والمترابط وفق مقتضيات بناء القصيدة، وكثيرا ما يكون للحوار حصة صريحة في تحريك التوتر عبر المواجهة بين أصوات متعارضة تفتقد للتفاهم والتواصل، كما يستعمل قصيدة الأقنعة لبناء حوار أو جدل مع شخصيات تاريخية عربية وعالمية، كأن يستحضر في قصيدة “هيلين يا له من مطر” شخصية “هيلين” المشهورة في حرب طروادة، من شخصيات ملحمة هوميروس (الإلياذة).
وقد يستحضر شخصيات أدبية وشعرية، مثل يانيس ريتسوس وبرتولد بريخت وبابلو نيرودا، إلى جانب التقنع بأصوات شعراء قدامى، كامرئ القيس والمتنبي وجميل بثينة ونحوهم، فكل هذه التجارب مما يقع في إغناء الدرامية وتعميقها في القصيدة الحديثة.
-
ثالثا: عز الدين المناصرة
تشرب عز الدين المناصرة (1946-2021) التوجهات الدرامية إلى جانب العديد من خصائص الملحمة، ودمجها في سياق اجتهاده في كتابة قصيدة جديدة ووفية في الوقت نفسه لهواجس التجربة الفلسطينية ونزعاتها وتعقيداتها التي كان شاهدا من شهودها في مختلف مراحل حياته.
ولذلك فإن عمله الشعري-النثري المبكر (كنعانياذا) بمقدار ما يشف عنه من عناصر ملحمية فإنه مفتوح على الدراما وعلى القصيدة الغنائية الرعوية التي تستحضر الحضارة الكنعانية الزراعية برموزها ومكوناتها المختلفة.
ومن الطرق التي تظهر فيها الخيوط الدرامية في تجربته ما عمد إليه من تصعيد الشخصيات الواقعية أو ذات الأصل الواقعي إلى مستوى الرمز والأسطورة، فعل ذلك في تقليباته وتنويعاته على شخصية “جفرا” فمرة هي الحبيبة، ومرة هي الأم، ومن شخصيتها الأمومية تولد شخصيتها العالية وذلك حين يجعل منها رمزا لفلسطين كلها في مستواها الأعلى، مضفيا عليها صفات تمكنها من خوض الصراع مع العدو والاحتلال، ومن أن تقاوم وتناور وصولا إلى أمل التحرر والانتصار.
إعلان
ومن القصائد الدرامية في تجربته قصيدته “كيف رقصت أم علي النصراوية: سيناريو المشهد”(18). وقد استحضر فيها شخصية واقعية تاريخية معروفة في الساحة الفلسطينية في سبعينات وثمانينات القرن العشرين، فهي أم الشهداء التي فقدت بنيها وودعت شهداء في ركب الثورة، ثم صارت أمّا للفدائيين جميعا، تودع الشهداء وتعتني بالأحياء، وتشارك في المظاهرات، وفي المواجهات، وترقص و”تهاهي” وتغني بما يتلاءم مع الظرف الفلسطيني الخاص.
إنها شخصية درامية جاهزة بمكوناتها الواقعية التي نتجت عن دراما الوضع الفلسطيني، وقد بنى الشاعر قصيدته على قصتها وقوة حضورها وعلى غنائها ورقصها، فأنتج ما يشبه السيناريو الشعري المؤثر، بما فيه من حركة ومن احتفالية خاصة، وعندما أنشد القصيدة اكتشف أنها تحتاج إنشادا خاصا مع هذه المكونات المتنوعة ومع طبيعة السيناريو بين الهبوط والصعود، والارتفاع والانخفاض، وتمثيل أصوات الترتيل مع المقاطع الغنائية المستوحاة من الغناء الشعبي الفلسطيني، إنها قصيدة هوية درامية بامتياز، في تركيزها على الشخصية وعلى التوتر العالي الناتج عن الحركة المتواترة فيها، وقد انعكس ذلك على طريقة أدائها أداء تمثيليا دراميا كان الشاعر يجهد في تقديمه بطريقة شفوية إنشادية دالة.
والطريقة الأخرى التي ظهرت في شعر المناصرة هي الطريقة التي شاعت في الشعر الحديث، مما يتصل باتخاذ الأقنعة، ذلك أن هذه الطريقة هي طريقة مسرحية ترتد إلى اتخاذ الممثل قناعا ليؤدي من ورائه شخصية معينة في بعض الأشكال المسرحية والتمثيلية، وقد استعارها الشعر الحديث مبكرا فظهرت عند البياتي والسياب، كما ظهرت في شعر صلاح عبد الصبور، وتميز فيها أمل دنقل ومنحها روحا جديدة استنادا إلى ما وجده فيها من تجاوب مع رؤيته ومراده، وقصيدته الشهيرة “لا تصالح” هي قصيدة قناع متفوقة. المناصرة مال مبكرا في طائفة من قصائده للتقنع ببعض الشخصيات كامرئ القيس وأبي محجن الثقفي وزرقاء اليمامة وغيرها.
إعلان
ولعل مجرد اتخاذ القناع يعني أن القصيدة الغنائية قد تخلت عن بعض معاييرها وسمحت للميول الموضوعية ولأصوات الآخرين بأن تظهر فيها، أي حتى لو كانت هذه الطريقة تتم في إطار الغنائية في نهاية الأمر فإنها تفقد صفاءها الغنائي لصالح تعدد الأصوات والدمج بين الشاعر الحديث ورمزه أو قناعه القديم، ومن جماع لغة الاثنين تولد هذه الدرامية الرمزية في أغلب الأحيان.
-
رابعا: وليد سيف
قدم وليد سيف (1948) تجربة شعرية مهمة من ناحية الاجتهاد في كتابة قصيدة حديثة تتميز بالانفتاح على المناخات الدرامية والملحمية، خصوصا في ديوانه “تغريبة بني فلسطين” 1979، وفيه ثلاث قصائد طويلة: تغريبة زيد الياسين، سيرة عبد الله بن صفية، مقتل زيد الياسين على طرف المخيم. وكتب بعد هذه التجربة قصيدة طويلة لم تظهر في ديوان، عنوانها “البحث عن عبد الله البري”.
وأما موهبة وليد سيف الدرامية فموهبة غير خافية، ولقد تجلت في اتجاهه لكتابة الدراما التلفزيونية، ما مكنه من الانتقال من الشعر بحدوده الغنائية والدرامية الضيقة نسبيا، إلى مساحة موسعة يمكنها أن تحمل وعيه الدرامي.
وقد يكون سيف أهم صوت شعري فلسطيني أنجز قصيدة درامية بمواصفات فنية متقدمة وبإحساس درامي عال، بالرغم من عدم التخلي عن تلك الكثافة الغنائية التي يصعب أن تتخلى عنها القصيدة الحديثة بل الشعر بشكل عام. فحتى في الشعر الدرامي التام (المسرحي)، يظل الصوت الغنائي وشبه الغنائي حاضرا في تلك المونولوجات التي تشكل تنويعا عاطفيا وذاتيا يعمق معنى الدراما ويطبعها بطابعه.
وقد لاحظ فخري صالح “أن الثنائية الأسطورية-التموزية (زيد الياسين-خضرة) هي (الموتيف) الأساسي المتكرر في قصائد (وشم على ذراع خضرة) وكذلك (تغريبة بني فلسطين) الذي بنى عليه وليد سيف عمله الشعري”(19). ولعل هذه الثنائية السردية-الأسطورية أحد مفاتيح المنظور الدرامي الحاضر في تجربة وليد سيف الشعرية.
إعلان
وامتدادا لذلك تتشكل الروح الدرامية في قصيدة سيف بطريقة قصصية، من خلال تعدد الأصوات وتنوع ضمائر السرد، أي أنها تأخذ شكلا قصصيا يتشرب روح الصراع الذي يحيط بالإنسان الفلسطيني، وهو صراع يتعدد فيه الأعداء ويتكاثرون، ولا يقتصر على العدو الصهيوني وحده، فهناك قوى التخلف العربي والرجعية التي تحد من نضاله، فزيد الياسين يظهر حبيسا قيد التعذيب في سجن عربي، لا صهيوني، وصراعه في القصيدة مع المخبر والسجان أكثر مما هو مع عدوه الرسمي، ومع ما يتعرض له من تعذيب فإن القصة تجنح إلى بعثه عبر أسطرته ليغدو متعددا لا واحدا، ولا شك في أن هذه الحلول الأسطورية هي إحدى السمات الملحمية، إذ يغدو بطلا خارقا بمكنته التجدد والانبعاث، رغم أنه قضى في حقيقة الأمر تحت سياط الجلادين وعصي رجال الأمن الساديين.
كذلك تتيح القصيدة ضروبا من الحوار الدرامي بين الشخصيات، وتستعمل ألوانا من حديث النفس أو المونولوج، تبعا لطبيعتها الدرامية والقصصية، وتصعد مواجهة حادة بين الماضي والحاضر من خلال استحضار التاريخ ومساءلته والبحث فيه عن بذور لأزمات الحاضر أو حلول لها، فالتاريخ سجل حافل بالعبر والهفوات في الآن نفسه.
كما نجد ألوانا من الثقافة الشعبية، كتوظيف الحكاية والأغاني الشعبية ونحو ذلك من ألوان “الفلكلور”، وتكفل هذه المواد للقصيدة أفقا جماعيا يتمثل في استحضار ثقافة الجماعة، وفي توسيع أفق القصيدة وربطها بمرجعيتها الثقافية، كأنما تعزز هذه العناصر التي ترتبط بالهوية الوطنية والجماعية، فزيد الياسين أو عبد الله بن صفية أو عبد الله البري ليسوا شخصيات مميزة بصفتهم أفرادا، وليسوا أبطالا أسطوريين لأسباب ذاتية، بل هم ممثلون عن الجماعة الثورية الفلسطينية بأسرها، إن كل واحد فيهم رمز للفدائي وللثائر بصورته النبيلة العالية، ولذلك فإن خضرة، أو المرأة أو المحبوبة التي كثيرا ما تظهر في مثل هذه القصائد، ليست في المقابل إلا فلسطين التي تغذ خطاها نحو الحرية.
إعلان
وختاما
أسهم الشعر الفلسطيني في تطوير القصيدة العربية الحديثة، من خلال اجتهاده في التعبير عن تعقيدات التجربة الفلسطينية واستلهام كثير من وقائعها وشخصياتها، والارتفاع بها من خلال طاقة الرمز والأسطورة إلى مستويات فنية تعكس ثراء الواقع، وتتطلع إلى رسم المستقبل الذي لا يتخلى عن حلم التحرير والعودة مهما تكن التضحيات جسيمة.
وقد مزج الشاعر الفلسطيني بين الغنائية والدرامية، بل حاول شيئا من الروح الملحمية، ليمكن للقصيدة أن تتسع وتمتد إلى ما هو أبعد من تجربة الذات ومناخاتها العاطفية، أي أن الدواعي الموضوعية والانتقال من الذات إلى الجماعة أحد المحركات والمؤثرات التي أسهمت في تطوير تقنيات وتوجهات جديدة اقتضت هذا الجدل بين الغنائية والدرامية، ومنحت من خلال ذلك طوابع كثيرة ميزت القصيدة المعاصرة، من بينها: توظيف الشخصيات والتقنيات المسرحية، والاهتمام بكرنفالية القصيدة وحركتها الجماعية، وتوظيف الأقنعة التي يتحدث الشاعر ضمنيا من ورائها، إلى جانب استخدام الأساليب والتقنيات الحوارية والسردية، ما نقل القصيدة المعاصرة إلى مناطق جديدة على المستوى الرؤيوي والأسلوبي.