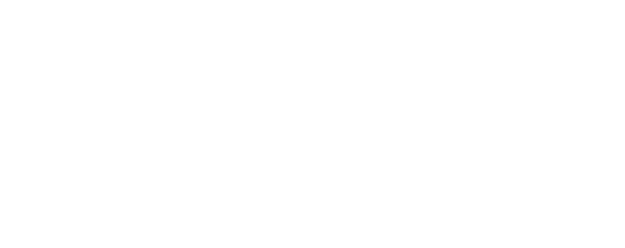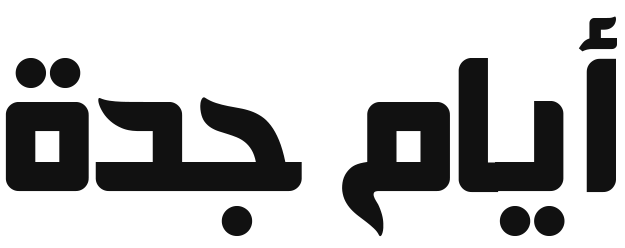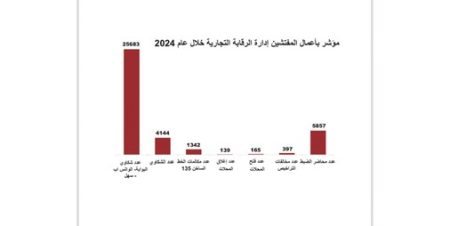- قانون «SURE» يقدم تصوراً جديداً للسياسة الجنائية للنفاذ الفوري للعقوبات
- إعادة العمل بالعقوبات التي تقل عن شهر واحد بعد أن ألغيت في إطار إصلاح العدالة لعام 2020
- تقليص نطاق منح عقوبة السجن الموقوف التنفيذ ليمنح فقط للمتهمين ممن لا يملكون أي سوابق جنائية
- الإلزام بتنفيذ العقوبة بمجرد صدورها دون منح المحكمة إمكانية تأجيل التنفيذ لأسباب تتعلق بوضع المحكوم عليه
أعد أستاذ القانون الجنائي د.فيصل الكندري دراسة تحليلية حول إصلاح القانون الجنائي الفرنسي لسنة 2025 تضمنت فلسفة العقوبة ومبررات التعديل وجدلياته الفقهية والقانونية، وجاء في الدراسة:
لا تبنى السياسة الجنائية في الدول الحديثة على مجرد رد الفعل تجاه الجريمة، بل تقوم على توازن دقيق بين مقتضيات النظام العام، وضرورات حماية الحقوق والحريات الفردية. وفي هذا السياق، تشكل القاعدة الجنائية في بعدها الموضوعي والإجرائي تعبيرا صريحا عن فلسفة الدولة في ضبط الفعل الإجرامي، وإرساء العدالة في معناها المؤسساتي لا الانتقامي. وإذا كان القانون الجنائي الفرنسي قد شهد إصلاحات متتالية منذ قانون نابليون عام 1810، فإن النقاش حول مدى فعالية الردع، وحدود العقوبة، وعلاقتها بحرية القاضي واستقلاليته، ظل قائما، وتجدد بقوة مع مشروع قانون العقوبات الجديد لسنة 2025، المعروف باسم مشروع قانون SURE (Sanction Utile، Rapide et Effective).هذا المشروع، الذي أعلن عنه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وتم تقديم خطوطه العامة في يوليو 2025، يمثل محاولة لإعادة صياغة الوظيفة العقابية في فرنسا عبر مسارين متوازيين: الأول يتمثل في تقليص تنوع العقوبات إلى أربع صور فقط، ما يفترض أنه تبسيط تشريعي ووسيلة للفعالية التنفيذية، والثاني في إصلاح مسار الإجراءات الجنائية، من خلال إعادة النظر في الحبس الاحتياطي، توسيع آلية الإقرار بالذنب لتشمل الجنايات، وتوسيع صلاحيات المحاكم الجنائية الإقليمية، فيما يمكن اعتباره مشروعا لإعادة هندسة العدالة الجنائية وفق منطق الفعالية والمؤشرات العددية.
غير أن هذا المشروع لم يمر دون إثارة موجة واسعة من الجدل القانوني والفقهي والسياسي، إذ اعتبره بعض القضاة انتكاسة لمكتسبات جوهرية كرسها القانون الفرنسي منذ أكثر من نصف قرن، وعلى رأسها مبدأ تفريد العقوبة، وحرية القاضي في التقدير، وعلنية المحاكمة، واستقلال قاضي تنفيذ العقوبة. كما رأت فيه نقابة القضاة (USM [12]) «مشروعا تقنيا ذا خلفية سياسية لا يراعي توازن العدالة، بل يخضعها لضرورات الشرطة والأمن العام». من جهة أخرى، دافع مؤيدو المشروع عن ضرورته في مواجهة ما وصفوه بـ«أزمة الردع»، وانهيار الثقة الشعبية في فعالية النظام القضائي، وهو ما استغلته التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة للمطالبة بإصلاح جذري للقانون الجنائي الفرنسي.
وتبدو أهمية هذا البحث في كونه لا يقتصر على عرض النصوص أو التعديلات، بل يتجاوزها إلى تفكيك البنية الفلسفية والسياسية لهذا المشروع، وتحليل مضامينه القانونية في ضوء الإطار الدستوري والاتفاقي الذي يضبط العدالة الجنائية في فرنسا، خاصة في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتوصيات مجلس أوروبا، ومواقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أولت اهتماما خاصا لمبدأ المحاكمة العادلة، وموقع الدفاع، والعلنية، وتناسب العقوبة مع شخصية الجاني.
كما يستمد الجانب المقارن في هذا البحث من ضرورة وضع التعديلات المقترحة في مواجهة النصوص القانونية المعمول بها حاليا، سواء في القانون الجنائي الموضوعي أو الإجرائي، لرصد التحولات لا من حيث الصياغة فقط، بل من حيث الدلالة والمنحى السياسي والتقني. وهذا يتطلب من الباحث تناول المشروع ضمن مسار تطور قانون العقوبات الفرنسي منذ 1992، مرورا بإصلاحات 2004 و2019 و2020، وصولا إلى النسخة الحالية، وربطها بالسياق الاجتماعي الذي أفرزها: تصاعد الجريمة في الضواحي، الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن، ضغط الرأي العام، وصعود الحركات الاحتجاجية المناهضة لما يسمى perceived as leniency.
وانطلاقا من هذه المعطيات، يمكن صياغة الإشكالية المحورية لهذا البحث على النحو الآتي:
إلى أي مدى تمثل التعديلات المقترحة في مشروع قانون العقوبات الفرنسي لسنة 2025 تطويرا فعليا وفعالا لمنظومة العدالة الجنائية؟ وهل تعكس هذه التعديلات تحسنا في الفعالية العقابية، أم أنها تؤسس لعدالة مختزلة تغلب السرعة والتنفيذ على حساب التفريد والضمانات الأساسية للمتهم والضحية؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، يتبع البحث منهجا تحليليا نقديا، يعتمد على:
٭ تحليل نصوص مشروع القانون كما وردت في المسودة الرسمية.
٭ مقارنتها بالنصوص الجنائية والإجرائية السارية حاليا.
٭ استقراء المواقف الفقهية والقضائية والنقابية بشأنها.
٭ ربط ذلك بالسياق الدستوري الفرنسي والمعايير الأوروبية ذات الصلة.
وسينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية:
1.المبحث الأول: التعديلات الجوهرية في النظام العقابي
يتناول إعادة تصنيف العقوبات، وتقييد تفريدها، وتشديد تنفيذها.
2.المبحث الثاني: إصلاح الإجراءات الجنائية وجدلية المحاكمة العادلة
يتناول توسيع آلية الاعتراف بالذنب، الحبس الاحتياطي، وتعديل الاختصاص القضائي.
3.المبحث الثالث: المقارنة الفقهية والتحليل القانوني بين المشروع والنظام المعمول به
يرصد الفروق الجوهرية، الخلفيات الفكرية، والجدل القانوني من حيث القبول والرفض.
المبحث الأول: التعديلات الجوهرية في بنية العقوبات وتوجهات الدولة نحو فعالية الردع
مقدمة المبحث
لطالما ارتبط النظام العقابي الفرنسي بتعدد صور العقوبات وتنوعها، بوصفها أداة لتحقيق العدالة الشخصية والإنصاف الفردي. وقد شكل مبدأ «تفريد العقوبة» أحد أبرز تجليات الفقه الجنائي الفرنسي الحديث، سواء من حيث قدرة القاضي على ملاءمة الحكم لطبيعة الجريمة وشخصية الجاني، أو من حيث التنوع الواسع في الوسائل العقابية، بين سالبة للحرية، ومقيدة لها، وبدائل قائمة على الخدمة العامة أو إصلاح السلوك.
لكن مشروع قانون SURE أتى محملا برؤية جديدة، تستند إلى أن كثرة أنواع العقوبات وتفرعها ساهم في إرباك القضاة، وتعطيل التنفيذ، وتقليص ثقة المجتمع في فعالية الردع، وهو ما يبرر، وفق منظور الحكومة، ضرورة إعادة هيكلة النظام العقابي، من حيث تصنيفه وشروط نفاذه. ومن هنا، يتضح أن المشرع في مشروع 2025 يسعى إلى تجاوز فلسفة «العدالة التفريدية»، لصالح ما يمكن تسميته بـ«العدالة التنفيذية»، أي نظام عقابي بسيط، موحد، سريع التفعيل، بصرف النظر عن الدلالات الفردية والاجتماعية الكامنة خلف الجريمة.
هذا التوجه يثير جدلا فقهيا عميقا، يتصل بمفهوم الردع، وحدود السلطة التقديرية، وتماسك البنية التشريعية، وهو ما يستدعي تحليلا مفصلا للركائز القانونية التي بني عليها هذا التحول، من خلال رصد أبرز مظاهر إعادة تشكيل العقوبة، في بنيتها، وصيغها، وآليات تنفيذها.
أولا: إعادة تصنيف العقوبات وتقليصها إلى أربع صور موحدة:
يمثل هذا التعديل أحد الأعمدة المركزية لمشروع قانون SURE. فقد نصت مسودة المشروع على تقليص أنواع العقوبات الجنائية إلى أربع فئات فقط، هي:
1.السجن (emprisonnement): كعقوبة أصلية في الجنح والجرائم.
2.الغرامة اليومية (jour-amende): جزاء مالي متجدد يفرض مقابل كل يوم من العقوبة، ويستبدل بالحبس في حال عدم الدفع.
3.الإشراف القضائي (probation judiciaire): وهو شكل من أشكال المراقبة القضائية المقننة.
4.القيود القانونية (interdictions/obligations): مثل المنع من الإقامة أو حيازة السلاح أو التواصل مع الضحية.
ويبرر هذا التقليص الحاد من قبل معدي المشروع بأن العقوبات الحالية التي يزيد عدد أنواعها على 230 وفق الإحصاءات القضائية أدت إلى حالة من التعقيد التشريعي، وجعلت التنفيذ الجنائي أكثر بطئا وغموضا، سواء على مستوى النيابات أو على مستوى الجهات المسؤولة عن تطبيق الأحكام.
لكن هذا الطرح، وإن بدا براغماتيا، يخفي تحولا فلسفيا عميقا، يتمثل في الانتقال من نموذج قائم على «الملاءمة الفردية» إلى نموذج قائم على «الوحدة الإجرائية». بمعنى أن العقوبة لم تعد تبنى على خصوصية الجريمة، بل على معيار تقني يتعلق بسهولة التنفيذ. وهذا ما يعارض، من وجهة نظر فقهية، المبدأ الذي أسس له القانون الجنائي الفرنسي في القرن العشرين، والذي يعتبر أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال مطابقة العقوبة لا للواقعة فقط، بل لشخصية مرتكبها.
ومن الناحية الدستورية، قد يثير هذا التقليص المطروح مسألة التناسب بين الفعل والعقوبة، الذي يشكل أحد أعمدة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789، والذي كرسه المجلس الدستوري الفرنسي في قراراته المتعلقة بحرية القاضي في التقدير. إذ إن حصر الخيارات، حتى لو لم يقيد النص صراحة، يؤدي وظيفيا إلى فرض نمط معين من العقوبات، وبالتالي الحد من حرية السلطة القضائية في إنتاج حكم عادل ومتناسب.
كما أن الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة لا يأخذ بعين الاعتبار الطابع الإصلاحي لبعض العقوبات البديلة التي سبق أن نص عليها القانون الفرنسي، مثل أعمال المنفعة العامة، والإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية، والعقوبات التعليمية للشباب، والتي شكلت في السابق جزءا من التوجه نحو العدالة التصالحية. بل إن الإلغاء الضمني لهذه الأدوات قد يؤثر سلبا على فرص إعادة التأهيل، ويزيد من نسب العودة إلى الجريمة، بما يتناقض مع أهداف العدالة الاجتماعية طويلة الأمد.
وفي السياق المقارن، تبرز أنظمة قانونية أوروبية مثل القانون الجنائي الألماني لا تزال متمسكة بالتفريد العقابي عبر توسيع نطاق التدابير والبدائل، لا اختزالها، ما يعكس اختلافا جوهريا في النظرة إلى وظيفة العقوبة: بين من يرى فيها وسيلة لضبط المجتمع بالقسر، ومن يراها أداة لتحويل السلوك بالوساطة والتدرج.
ثانيا: تقليص السلطة التقديرية للقاضي وإعادة الاعتبار للعقوبات الدنيا:
من بين أخطر ما جاء به مشروع قانون SURE من تعديلات على البنية العقابية الفرنسية، هو التوجه الصريح نحو تقييد السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، سواء في اختيار العقوبة أو في تقرير كيفية تنفيذها. ويتجلى هذا التوجه في نقطتين جوهريتين: أولاهما إعادة العمل بنظام «العقوبات الدنيا» (peines plancher)، وثانيهما تقليص حالات منح الحبس مع وقف التنفيذ، بما يعكس إرادة المشرع في استعادة ما يعتبره «فعالية قضائية ضائعة»، حتى ولو على حساب تفريد العقوبة وتناسبها.
1. العودة إلى نظام العقوبات الدنيا:
يعد مبدأ «العقوبات الدنيا» أحد الآليات العقابية التي أثارت ولا تزال تثير جدلا كبيرا في الفقه الجنائي، سواء في فرنسا أو في الأنظمة المقارنة. وقد سبق أن جرب هذا النظام في فرنسا بموجب قانون 10 أغسطس 2007، قبل أن يتم التراجع عنه تدريجيا بسبب الانتقادات الشديدة التي طالت آثاره على استقلال القضاء. ويقوم هذا النظام على فرض حد أدنى من العقوبة في حالات معينة، خاصة عند تكرار ارتكاب الجريمة، بحيث لا يجوز للقاضي النزول تحته إلا لأسباب استثنائية ومعللة.
وفي إطار مشروع قانون SURE، تم اقتراح إعادة العقوبات الدنيا لا فقط في حال التكرار، بل حتى عند ارتكاب الجريمة لأول مرة، خاصة في القضايا المرتبطة بالاعتداءات على ممثلي السلطة العامة (شرطة، درك، سجون…). ويمثل هذا التوسيع نقلة نوعية في فلسفة الردع، من نظام مرن يتدرج تبعا للفعل وظروفه، إلى نظام آلي يفرض جزاء جاهزا لا يراعي إلا وصف الجريمة لا سياقها أو شخص مرتكبها.
ويثير هذا الإجراء جدلية عميقة تتعلق بمبدأ تفريد العقوبة، الذي يعتبر في الفقه الفرنسي مظهرا من مظاهر العدالة الشخصية (justice individualisée)، والتي أكدها المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الشهير رقم 2007-554 DC، حين اعتبر أن «القاضي يجب أن يحتفظ بسلطة تحديد العقوبة بما يتناسب مع ظروف الواقعة وشخص مرتكبها، وإلا وقع النص التشريعي في مخالفة لمبدأ التناسب».
والحال أن نظام العقوبات الدنيا يجرد القاضي من هذه السلطة، ويحوله إلى مجرد منفذ لحد أدنى مفروض سلفا، مما يفقد العملية القضائية معناها التقييمي والإنساني. والأسوأ من ذلك أن النص المقترح لا يضع شروطا مشددة لتطبيق هذا الحد الأدنى، بل يربطه بصفات المجني عليه (كونه موظفا عاما) لا بخطورة الجاني أو سوابقه، مما يخل بالتوازن الذي قامت عليه فلسفة التجريم والعقاب.
2. التضييق على منح الحبس مع وقف التنفيذ:
إلى جانب إعادة العقوبات الدنيا، يقترح في المشروع تقليص نطاق منح عقوبة السجن الموقوف التنفيذ (sursis simple)، بحيث تمنح فقط للمتهمين الذين لا يملكون أي سوابق جنائية، ولم يصدر بحقهم أي حكم سابق. وهذا النص، وإن كان يهدف إلى التشدد في التعامل مع المعتادين على الإجرام، إلا أنه يسقط من الاعتبار البعد الإصلاحي الذي طبع نظام العقوبات في فرنسا منذ إصلاحات عام 2000، التي اعتبرت السجن مع وقف التنفيذ أداة لتفادي الاكتظاظ السجني، وتشجيع الإدماج الاجتماعي.
إن الحد من إمكانية منح السجن مع وقف التنفيذ يعيد إنتاج منطق الردع السلبي (dissuasion passive)، الذي يركز على العقوبة كنهاية بحد ذاتها، لا كوسيلة إصلاحية. وقد كتب الفقيه Stéphane Detraz [2] أن «التشريع الذي يمنع القاضي من التدرج في الردع، هو تشريع يصنع في البرلمان لكنه ينفذ في العشوائية الواقعية»، في إشارة إلى أن النصوص غير القابلة للتكييف تنتج أحكاما قد تكون قانونية من حيث الشكل، لكنها جائرة من حيث الأثر.
كما أن هذا التقييد يضعف دور الدفاع، ويهمش الآليات التفاوضية التي تسمح ببناء مسار إدماجي، خاصة إذا علمنا أن العديد من القضايا ذات الطابع الاجتماعي (كالعنف العائلي أو الجنح الاقتصادية البسيطة) تستدعي من القاضي مرونة لا مجرد تطبيق ميكانيكي للقانون.
من زاوية مقارنة، فإن العودة إلى العقوبات الدنيا والحد من السجن مع وقف التنفيذ يعد انحرافا عن توجهات الأنظمة الجنائية الأوروبية، التي تميل إلى تقليص العقوبة السالبة للحرية، واعتماد الوسائل البديلة، كما هو الحال في ألمانيا وإسبانيا وهولندا، حيث تمثل السجن الموقوف التنفيذ أداة رئيسة لتحقيق ما يسمى بـ«العدالة الإصلاحية» (justice réparatrice).
ثالثا: تشديد قواعد تنفيذ العقوبة والتخلي عن فلسفة التأجيل والتدرج:
إذا كان قانون العقوبات الفرنسي في صورته المعمول بها قد تبنى، على مدى عقود، سياسة جنائية قائمة على مبدأ «تدرج التنفيذ» (progressivité de l’exécution)، أي أن العقوبة تنفذ وفق اعتبارات اجتماعية وقضائية تأخذ في الاعتبار طبيعة الجاني، وخطورة الفعل، وإمكانية الإدماج، فإن مشروع قانون SURE يذهب في اتجاه معاكس، يكرس فيه منطق «النفاذ الفوري» (exécution immédiate de la peine)، ويقلص من مرونة التكييف التنفيذي، سواء من خلال تقليص دور قاضي تطبيق العقوبة، أو من خلال تقليص إمكانية التأجيل، أو عبر إعادة إحياء العقوبات القصيرة التي ألغيت سابقا لأسباب إصلاحية.
1. فرض التنفيذ الفوري للعقوبة دون إمكانية التأجيل:
من أبرز ما جاء به مشروع قانون SURE هو الإلزام بتنفيذ العقوبة بمجرد صدورها، دون منح المحكمة أو قاضي التنفيذ إمكانية تأجيل التنفيذ لأسباب تتعلق بالوضع الشخصي للمحكوم عليه، أو بقدرة المؤسسات العقابية على الاستيعاب. وقد نص في مسودة المشروع على أن «كل حكم بعقوبة سالبة للحرية يكون واجب النفاذ خلال أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره»، ما يفقد القاضي آلياته التقليدية في ضبط توقيت التنفيذ وتدرجه.
ويثير هذا التوجه انتقادات حادة، لأنه يقوض التفرقة الوظيفية بين سلطة الحكم وسلطة التنفيذ، ويجعل القرار القضائي النهائي بمثابة أمر إداري مباشر، لا يخضع لمراقبة قاضي تنفيذ العقوبة (juge de l’application des peines). بل إن هذا الاتجاه يتعارض مع الفقه الجنائي الفرنسي الذي منح منذ قانون مارس 2004 صلاحيات واسعة لقاضي التنفيذ لإعادة تكييف العقوبة بما يتلاءم مع المستجدات الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، وذلك في إطار ما يعرف بـ «العدالة التنفيذية» (justice de l’exécution).
كما أن هذا الإجراء يثير، من زاوية دستورية، مسألة مدى احترام مبدأ «المحاكمة العادلة» كما ورد في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تقتضي أن يكون التنفيذ خاضعا لرقابة قضائية، لا لتعليمات السلطة التنفيذية أو لأجندتها الأمنية. وفي هذا السياق، حذرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في عدة قرارات، من خطر تحويل القضاء الجنائي إلى أداة تنفيذية بحتة، ومن أبرزها قرارها في قضية Bouamar c. Belgique، الذي شدد على ضرورة التمييز بين سلطة القضاء وسلطة الشرطة العقابية.
2. إحياء عقوبة الحبس القصير رغم إلغائها سابقا:
ضمن هذا المنطق الجديد، اقترح مشروع القانون إعادة العمل بالعقوبات السالبة للحرية التي تقل عن شهر واحد، والتي سبق أن ألغيت في إطار إصلاح العدالة لعام 2020، على اعتبار أن هذه العقوبات القصيرة غير مجدية، وتشكل عبئا إداريا على المؤسسات العقابية، دون أن تحقق أثرا ردعيا أو إصلاحيا فعليا.
إلا أن وزير العدل في تبريره لهذا الإجراء الجديد، اعتبر أن العقوبات القصيرة «ذات قيمة رمزية رادعة»، خاصة في قضايا متكررة كالسرقة البسيطة أو التهديد اللفظي أو مقاومة رجال الشرطة. وذهب إلى أن عدم تنفيذ العقوبة أصلا أشد خطورة من تنفيذ عقوبة رمزية، إذ إن الإفلات الظاهر من العقوبة ينتج في تقديره شعورا عاما بانعدام الردع.
غير أن هذا التوجه يتعارض، بشكل مباشر، مع أدبيات علم العقوبة المعاصر، الذي يؤكد على أن العقوبات القصيرة، لاسيما إن كانت غير مصحوبة ببرنامج إعادة تأهيل، لا تحقق أي غرض إصلاحي، بل قد تفاقم من سلوك الإجرام العائد، وتؤدي إلى تهميش اجتماعي دائم. وقد خلص تقرير صادر عن المجلس الأعلى للعدالة الفرنسية سنة 2019 إلى أن «العقوبات القصيرة لا تمكن النظام من تحقيق الإدماج، بل تحول المؤسسات العقابية إلى نقطة عبور نحو التكرار الإجرامي».
3. إضعاف دور قاضي تنفيذ العقوبة:
في الوقت ذاته، يعمد المشروع إلى إعادة تعريف دور قاضي تنفيذ العقوبة، بشكل يقيد من هامش سلطته في تكييف العقوبة مع متغيرات الواقع. إذ لم ينص المشروع على صلاحيات جديدة، بل جاء بمجموعة من الضوابط التي تحظر على هذا القاضي تأجيل تنفيذ الأحكام أو تعديل طبيعتها، إلا بموجب موافقة مسبقة من المدعي العام أو رئيس المحكمة، ما يفتح الباب أمام تسييس التنفيذ، ويقوض استقلالية القاضي في مرحلة ما بعد النطق بالحكم.
ويمثل هذا التراجع انحرافا عن منطق «القاضي المستمر» (juge permanent)، الذي أسس له في فرنسا لتأمين الرقابة القضائية على مدة العقوبة، وأثرها، وإمكانية تعديلها تبعا لمجهود المحكوم عليه في الإدماج أو التعويض أو الإصلاح.
ومن زاوية مقارنة، فإن معظم الأنظمة الأوروبية، لا سيما في ألمانيا والسويد، تعتمد على قضاة مختصين في مراقبة تنفيذ الأحكام، بصلاحيات موسعة تسمح لهم باستبدال العقوبة أو تكييفها، في ضوء مصلحة إعادة التأهيل والعودة إلى المجتمع.
المبحث الثاني: التحولات الإجرائية في مشروع قانون SURE وإشكاليات التوازن بين الفعالية وضمانات العدالة
مقدمة المبحث:
إن الإجراءات الجنائية لا تقل أهمية عن قواعد التجريم والعقاب في تحقيق العدالة، بل يمكن القول إن الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة والإجراءات المنصفة تمثل، في النظم القانونية الحديثة، القيد الأساسي الذي يمنع انزلاق الدولة نحو ممارسة تعسفية للسلطة العقابية. ومن هذا المنطلق، قامت المنظومة الإجرائية الفرنسية، كما تطورت منذ قانون الإجراءات الجنائية لعام 1958، على أساس تحقيق التوازن بين المصلحة العامة في تتبع الجريمة، والمصلحة الفردية في صون الحرية والكرامة وضمان حق الدفاع.
لكن مشروع قانون SURE لا يكتفي بإصلاح بنية العقوبة، بل يمتد إلى تعديل البنية الإجرائية ذاتها، وذلك عبر إدخال أدوات جديدة، وتوسيع آليات مختصرة للمحاسبة، والحد من بعض المعايير القضائية الراسخة. ففي إطار سعيه إلى «تسريع» العدالة، يقترح توسيع نطاق تطبيق آلية الإقرار بالذنب لتشمل الجنايات، كما يعاد تعريف مبررات الحبس الاحتياطي، ويوسع اختصاص المحاكم الجنائية الإقليمية، على حساب محكمة الجنايات ذات التكوين الشعبي.
هذه الإجراءات، على الرغم من تبريرها بالفعالية والسرعة، تثير قلقا مشروعا من قبل كثير من القضاة والفقهاء، إذ قد تؤدي إلى إضعاف الضمانات التي تعد جوهر العدالة الجنائية: الحق في المثول أمام قاض طبيعي، علانية الجلسات، حيادية المحكمة، وتمكين الدفاع والضحية من لعب دور فعال في سير الإجراءات.
وبالتالي، فإن تحليل هذه التحولات لا يقتصر على استعراض مضمون النصوص، بل يتطلب تأصيلا قانونيا يتناول مدى انسجام هذه التعديلات مع المبادئ الدستورية الفرنسية، ومع المعايير الأوروبية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاجتهادات المستقرة لمحكمتها في ستراسبورغ.
أولا: توسيع آلية الإقرار بالذنب وتجاوز حدودها التقليدية:
1. تطور الإقرار بالذنب في النظام الفرنسي: من الجنح إلى الجنايات:
يعد الإقرار بالذنب (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – CRPC)، كما استورد إلى النظام الفرنسي من النظام الأنجلوساكسوني، أحد أبرز الابتكارات الإجرائية التي تهدف إلى تسريع العدالة الجنائية وتخفيف العبء عن المحاكم. وقد تم إدراجه أول مرة في التشريع الفرنسي بموجب قانون 9 مارس 2004، في سياق يعرف بـ«عدالة التفاوض» (justice négociée)، وهو مسار يتيح للنيابة العامة اقتراح عقوبة على المتهم الذي يعترف بذنبه، لتتم المصادقة عليها من قبل قاض، دون الحاجة إلى إجراء محاكمة كاملة.
لكن نطاق هذه الآلية، منذ نشأتها، كان محصورا في الجنح فقط، باستثناء بعض القضايا التي تتعلق بالأحداث أو الجرائم الاقتصادية. وقد برر المشرع هذا الحصر بأن الجنايات لطبيعتها الخطيرة وأثرها الاجتماعي تتطلب محاكمة علنية تامة، تمكن الضحية من التعبير، والدفاع من التدخل، والمحكمة من النظر في العناصر المادية والمعنوية للفعل بترو واستقلالية.
غير أن مشروع قانون SURE يقترح، ولأول مرة، توسيع هذه الآلية لتشمل بعض الجرائم، شريطة ألا تتجاوز العقوبة المقترحة ثلثي الحد الأقصى المقرر قانونا، وأن تكون موافقة الضحية صريحة، وأن يعرض الاتفاق على قاض جنائي للمصادقة.
2. إخلالات هيكلية بحق الدفاع ودور الضحية:
ورغم محاولة المشرع تقييد تطبيق هذا المسار ببعض الضمانات الشكلية، فإن توسيعه ليشمل الجنايات يطرح إشكالات جوهرية، تتعلق ببنية العدالة الجنائية نفسها، إذ ينقل هذا النظام مركز ثقل المحاكمة من المحكمة إلى مكتب المدعي العام. فبدلا من أن تبنى العقوبة على مداولات قضائية موضوعية، تصبح نتيجة تفاوض بين النيابة والدفاع، في معادلة قد تفتقر إلى التوازن الفعلي، لا سيما في ظل غياب التحقيق القضائي الكامل.
وقد حذر الفقه الفرنسي، خاصة في كتابات Dominique Inchauspé، من هذا المنحى، مؤكدا أن «إدخال منطق الصفقة في مجال الجنايات يهدد الطابع العلني والرمزي للعدالة، ويحرم المجتمع من لحظة الكشف عن الحقيقة الجنائية».
فالعدالة الجنائية، خصوصا في الجنايات، لا تهدف فقط إلى معاقبة الجاني، بل إلى بناء سردية قضائية متكاملة حول الفعل، والمسؤولية، والأثر، وهو ما يصعب اختزاله في إجراء إداري سريع.
أما من زاوية حقوق الضحية، فإن موافقة هذه الأخيرة، رغم النص عليها، قد تكون شكلية أو تحت الضغط، خاصة في غياب تمكين فعلي من الحضور والمشاركة المؤثرة في التفاوض. وقد لاحظت الهيئة الوطنية لمساعدة الضحايا (FENVAC) أن «العدالة التفاوضية تهمش الضحايا، وتحولهم إلى متفرجين، في حين أن الجناية تمس بهم جوهريا وتستدعي اعترافا علنيا بمعاناتهم».
3. المساس بمبدأ العلنية وعلو وظيفة القضاء:
يتعارض هذا التوسيع مع مبدأ العلنية، الذي يعد من المبادئ الدستورية للمحاكمة، كما نصت عليه المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن «لكل شخص الحق في محاكمة علنية عادلة تفصل فيها محكمة مستقلة ونزيهة».
وتتمثل خطورة هذا المسار في أنه يقصي الرقابة الشعبية على العدالة، ويفرغ الجناية من بعدها العام، لتصبح مسألة إدارية تعالج في المكاتب بدلا من قاعات الجلسات.
ومن وجهة نظر قضائية، فإن هذا الاتجاه يقزم دور القاضي الجنائي، ويجعل من المصادقة على الاتفاق وظيفة شكلية، إذ لا تتوفر للمحكمة الأدوات الكاملة لفهم الوقائع أو إعادة تقييم العقوبة، ما يحولها من هيئة موضوعية إلى سلطة تصديق.
وقد حذر المجلس الأعلى للقضاء في تقريره لسنة 2025 من مغبة هذا التحول، معتبرا أن «توسيع CRPC إلى الجنايات يفرغ العدالة من محتواها الرمزي، ويخلق تفاوتا بين المتهمين القادرين على التفاوض، وأولئك الذين يخضعون للمسار الكامل، مما يخل بالمساواة أمام العدالة».
ثانيا: إعادة تعريف معايير الحبس الاحتياطي وإدخال معيار «اضطراب النظام العام»
1. الحبس الاحتياطي كاستثناء لا كأصل:
لطالما تعاملت المنظومة القانونية الفرنسية، في نسختها المعاصرة، مع الحبس الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى. وقد جاء هذا التوجه ثمرة اجتهادات فقهية وقضائية تراكمت منذ عقود، انطلاقا من مبدأ «قرينة البراءة»، ومرورا بتكريس «حرية المتهم» كقاعدة عامة، لا يجوز تقييدها إلا بقرار معلل ومبرر، ضمن ضوابط صارمة نصت عليها المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
وبناء عليه، لا يمكن حبس شخص احتياطيا إلا إذا توفرت أسباب حقيقية تبرر ذلك، من قبيل خطر الفرار، التأثير على الشهود، تكرار الجريمة، أو تعريض المجني عليه للخطر. وكان على القاضي أن يفصل هذه الأسباب بشكل موضوعي وشخصي، بناء على الوقائع وظروف المتهم، لا مجرد صفة الجريمة أو الأثر الاجتماعي لها.
2. التعديل المقترح: إدخال معيار “الاضطراب العام”:
لكن مشروع قانون SURE، في توجهه نحو «فعالية قضائية سريعة»، يقترح إدراج معيار جديد يضاف إلى المعايير المعروفة لتبرير الحبس الاحتياطي، يتمثل في: «الاضطراب الشديد الذي يخل بالنظام العام نتيجة لخطورة الجريمة المرتكبة».
وهو معيار ذو طابع عام وتجريدي، لا يرتبط مباشرة بشخص المتهم أو بسلوكه، وإنما بآثار الجريمة المتصورة على المحيط الاجتماعي أو الإعلامي أو السياسي. وبهذا، تنتقل علة الحبس من المجال الشخصي إلى المجال الرمزي، بحيث يصبح الحبس أداة لطمأنة الرأي العام، لا لحماية سير العدالة أو الوقاية من الجريمة.
وقد أثار هذا التعديل المقترح موجة من التحفظات داخل الأوساط القضائية والحقوقية، إذ ينظر إليه كمدخل محتمل للتعسف في استعمال الحبس الاحتياطي، لكونه معيارا غير قابل للضبط الموضوعي، وقابل للتسييس. إذ يكفي أن تكون الجريمة قد أثارت تغطية إعلامية واسعة أو أثرت على «السكينة العامة»، حتى يبرر الحبس، بصرف النظر عن موقف المتهم من الوقائع أو خطورة حالته الشخصية.
3. موقف الفقه والاجتهاد القضائي:
يرى عدد من فقهاء القانون أن إدخال معيار «الاضطراب العام» يشكل تهديدا صريحا لمبدأ قرينة البراءة. وقد كتب Jean Danet أن «الربط بين الحبس ووقع الجريمة على المجتمع يحول العدالة من نظام موضوعي إلى استجابة انفعالية»، معتبرا أن القاضي يصبح خاضعا لضغط الرأي العام، لا لسلطان القانون والوقائع.
كما اعتبرت نقابة القضاة (USM [12]) في بيانها الصادر في يوليو 2025 أن هذا المعيار «فضفاض بطبيعته، ويجعل قرار الحبس مرتهنا بانطباعات إعلامية أو سياسية»، وهو ما يتناقض مع مبدأ الاستقلال والحياد، خاصة في القضايا الحساسة ذات الطابع الاجتماعي أو الديني أو السياسي.
أما من الناحية القضائية، فإن الاجتهاد الفرنسي والمقارن يميل إلى رفض هذا النوع من المعايير الرمزية. ففي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 6 نوفمبر 2018، شددت المحكمة على أنه «لا يجوز تبرير الحبس الاحتياطي إلا بوقائع دقيقة تتعلق مباشرة بشخص المتهم، ولا يكفي الاستناد إلى خطورة الجريمة أو أثرها العام».
وفي السياق الأوروبي، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرارها في قضية Letellier c. France [6] (1991)، أن الحفاظ على النظام العام، وإن كان هدفا مشروعا، لا يمكن أن يستخدم كمبرر وحيد للحبس المؤقت، ما لم يقترن بعناصر واقعية وشخصية تدل على خطورة المتهم أو تهديده المباشر للعدالة.
4. تداعيات المعيار الجديد على مبدأ العدالة المتساوية:
إن إدخال هذا المعيار لا يمس فقط بالقرينة، بل يهدد مبدأ المساواة أمام القانون، إذ تصبح بعض الجرائم بسبب أثرها الرمزي أو صداها الإعلامي مبررا للحبس، في حين يترك غيرها دون تقييد، رغم تساوي الفعل من الناحية القانونية. وقد يؤدي ذلك إلى تمييز غير مشروع، ويحدث انحرافا وظيفيا في وظيفة الحبس الاحتياطي، فيتحول من وسيلة احترازية إلى عقوبة فعلية تمارس قبل صدور الحكم.
ثالثا: توسيع اختصاص المحاكم الجنائية الإقليمية وتقليص دور المحلفين:
1. الإطار العام للمحكمة الجنائية الإقليمية:
شهد النظام القضائي الفرنسي تحولا تدريجيا في بنيته منذ سنة 2019، حين تم إنشاء «المحاكم الجنائية الإقليمية» (Cours criminelles départementales) كتجربة بديلة لمحكمة الجنايات التقليدية، لاختصار زمن المحاكمة وتخفيف العبء الناتج عن آلية المحلفين. وقد خصصت هذه المحاكم، في صيغتها الأولى، للنظر في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها عشرين سنة سجنا، وتشكل من خمسة قضاة محترفين، دون مشاركة للمواطنين المحلفين.
ورغم الجدل الذي رافق هذا التأسيس، اعتبره البعض إجراء إداريا محضا يحافظ على التوازن بين الكفاءة القضائية والفعالية الزمنية، طالما أن اختصاصها يظل محصورا في فئة محددة من الجرائم.
2. التوسع المقترح في مشروع قانون SURE:
لكن مشروع قانون SURE يقترح توسيع صلاحيات هذه المحاكم بشكل كبير، لتشمل النظر في جميع أنواع الجنايات، باستثناء القضايا الخاصة (مثل الإرهاب أو جرائم القتل العمد المرتبطة بظروف مشددة)، بل ومنحها صلاحية الفصل في الاستئنافات، وعقد الجلسات خارج نطاق المحكمة الإقليمية الأصلية، ضمن ما يسمى بـ«المحكمة المتنقلة»، في محاولة لتعزيز العدالة المحلية السريعة.
وتمثل هذه التوسعة، من وجهة نظر فقهية، نقطة انعطاف خطيرة في تنظيم القضاء الجنائي، إذ تعيد تشكيل مفهوم «القاضي الطبيعي»، وتجعل المحاكمات الجنائية تدار، ليس باسم الشعب، وإنما باسم الإدارة القضائية المختصة.
3. المساس بمبدأ المشاركة الشعبية في العدالة الجنائية:
تعد محكمة الجنايات في صورتها التقليدية إحدى الركائز المميزة للنظام القضائي الفرنسي، كونها تعتمد على هيئة المحلفين (jurés populaires)، التي تمثل حضور الشعب في عملية إحقاق العدالة. وهذا المفهوم يجسد مبدأ ديمقراطيا عميقا، قوامه أن أخطر أنواع العقوبات، التي تمس الحرية وربما الحياة، لا تقرر فقط من قبل قضاة محترفين، بل بمشاركة مواطنين يمثلون الحس العام والأخلاقي والاجتماعي.
وقد أكد الفقيه Antoine Garapon [3] أن «المحكمة الجنائية ليست فقط مؤسسة قضائية، بل هي مؤسسة تربوية وطنية، فيها يدرب المواطن على مسؤولية الحكم، وعلى مواجهة الحقيقة بشجاعة». ولهذا، فإن تقليص دور هيئة المحلفين في قضايا الجنايات الكبرى لا يعد مجرد تعديل تقني، بل يمثل تراجعا عن الرؤية التشاركية للعدالة، لصالح نموذج تكنوقراطي إداري.
4. الإشكاليات الدستورية ومخاوف التسييس:
إن إسناد الاختصاص في قضايا خطيرة إلى محكمة مكونة فقط من قضاة مهنيين، دون رقابة شعبية، يفتح الباب أمام مخاوف متعددة، أبرزها: احتمال التأثر بالضغوط السياسية أو الإعلامية، وتقييد استقلالية القاضي الطبيعي، بل وتكريس نوع من المركزية العقابية التي تتعارض مع مبدأ التنوع القضائي.
وقد عبرت نقابة المحامين في باريس عن رفضها لهذا التوجه، معتبرة أن «التوسع في اختصاص المحاكم الإقليمية يضعف ضمانات المحاكمة العادلة، ويختزل الجناية إلى ملف ينظر فيه إداريا، بدل أن يحاكم مجتمعيا».
ومن جهة أخرى، فإن حذف هيئة المحلفين قد يتعارض مع المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة في تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ربطت مفهوم «المحكمة المستقلة» بإمكانية مراقبة السلطة القضائية من قبل عناصر غير منتمية للجهاز الرسمي، أي المحلفين كممثلين للمجتمع المدني.
5. أثر ذلك على علنية المحاكمة والحق في الدفاع:
تؤدي هذه التعديلات إلى إضعاف البعد العلني للمحاكمات، حيث إن المحاكم الجنائية الإقليمية، بتكوينها الضيق، تعقد جلسات مختصرة وسريعة، في بيئة تفتقر في أحيان كثيرة إلى الرمزية القضائية التي تميز محكمة الجنايات الكبرى. ويؤدي هذا إلى تقليص الحضور الرمزي للعدالة، ويحول المحاكمة إلى إجراء إجرائي بحت، مما يؤثر على تمكين الدفاع، ويضعف حق الضحية في الاستماع والحضور والمشاركة.
رابعا: إضعاف دور قاضي تطبيق العقوبة وإعادة تشكيل مرحلة التنفيذ:
1. المكانة التقليدية لقاضي تطبيق العقوبة في النظام الفرنسي:
يشكل قاضي تطبيق العقوبة في القانون الفرنسي حجر الزاوية في مرحلة ما بعد الحكم، حيث يتولى سلطة الإشراف القضائي على تنفيذ الأحكام الجنائية، بما في ذلك إمكانية تعديل طريقة التنفيذ، أو استبدال العقوبة بأخرى، أو تقديم جدول زمني للتنفيذ، وذلك مراعاة لظروف المحكوم عليه، وحفاظا على مبدأي التناسب والملاءمة.
وقد نصت المادة 707 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن «العقوبة لا تكون فقط حصرا في محتواها القانوني، بل في ظروف تنفيذها»، مما يعني أن التنفيذ ليس مجرد ترجمة ميكانيكية للحكم، بل عملية قانونية قائمة بذاتها تخضع للسلطة القضائية، وتراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والجنائية الخاصة بكل حالة.
وفي هذا السياق، تعززت وظيفة قاضي تنفيذ العقوبة بعد الإصلاحات المتلاحقة، خاصة في الأعوام 2004 و2009، حيث تم الاعتراف به كـ«قاض متخصص» يمارس صلاحيات مستقلة، ويملك أدوات لتكييف العقوبة، بما يخدم إعادة التأهيل، والتدرج في الانتقال من العقوبة السالبة للحرية إلى العقوبة البديلة أو المشروطة، كلما سمحت مصلحة العدالة والاندماج بذلك.
2. التعديلات المقترحة في مشروع قانون SURE: تقييد الصلاحيات وتحجيم الوظيفة:
رغم كل هذه المكتسبات، يأتي مشروع قانون SURE ليقيد بشكل واضح من صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبة. فوفق ما ورد في مسودة المشروع، فإن أي تعديل في طبيعة تنفيذ العقوبة (كتحويل الحبس إلى مراقبة إلكترونية أو إطلاق مشروط) يجب أن يخضع لموافقة مسبقة من النيابة العامة، أو يتطلب إذنا خاصا من المحكمة التي أصدرت الحكم، مما يحول قاضي التنفيذ من سلطة مستقلة إلى مجرد وسيط إداري.
كما ينص المشروع على تحديد قائمة مغلقة بالإجراءات التي يجوز لقاضي التنفيذ اتخاذها، مع فرض آجال زمنية ضيقة تمنعه من التدخل ما لم تكن هناك “ضرورة ملحة ومثبتة”، دون توضيح موضوعي لماهية هذه الضرورة.
ويظهر من خلال ذلك أن المشروع يطمح إلى تقليص الدور الاجتهادي لقاضي التنفيذ، وتغليب الطابع التنفيذي المجرد على الطابع القضائي، مما قد يؤدي إلى فقدان هذه المرحلة لأهم خصائصها: المرونة، والعدالة الشخصية، والتدرج في الردع.
3. نقد الفقه والقضاء لهذا الاتجاه:
لاقى هذا التوجه تحفظا واسعا من قبل القضاة والباحثين، إذ اعتبر الكثيرون أن تقييد سلطة قاضي التنفيذ يناقض فلسفة العدالة الحديثة، التي لا ترى في العقوبة مجرد وسيلة للقصاص، بل أداة لإعادة الإدماج والتقويم.
وقد كتب Dominique Raimbourg [9]، القاضي والنائب السابق في الجمعية الوطنية، أن «إضعاف سلطة قاضي تنفيذ العقوبة هو بمثابة الحكم بالإعدام على وظيفة العدالة التأهيلية، وتحويل العقوبة إلى آلية انتقامية غير قابلة للمراجعة».
وفي الاتجاه ذاته، اعتبرت نقابة القضاة الفرنسيين (SM) أن مشروع القانون يسعى إلى «إلغاء قاضي التنفيذ دون أن يعلن ذلك صراحة»، عبر إحاطته بقيود إجرائية وشرطية تجعله عاجزا عن أداء مهامه الجوهرية، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال القاضي المنصوص عليه في المادة 64 من الدستور الفرنسي.
كما حذرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرارها في قضية Horych c. Pologne [7] (2012)، من أن «تنفيذ العقوبة يجب أن يخضع لرقابة قضائية مستقلة وفعالة، وإلا فقدت العقوبة طابعها الإنساني والشرعي»، وهو ما يشير إلى أن تجريد قاضي التنفيذ من سلطته التقديرية قد يمثل إخلالا بالتزامات فرنسا الاتفاقية.
4. المخاطر العملية لهذا التوجه:
من الناحية العملية، فإن تقييد سلطة قاضي تنفيذ العقوبة ينتج عدة آثار سلبية:
٭ أولا، غياب المرونة في التنفيذ قد يؤدي إلى الزيادة في الاكتظاظ السجني، نتيجة منع آليات التخفيف.
٭ ثانيا، المساس بإمكانية المحكوم عليه في طلب إعادة التأهيل التدريجي، خصوصا في الحالات التي يثبت فيها السلوك الإيجابي.
٭ ثالثا، فقدان ثقة الفاعلين في النظام القضائي، خصوصا المحامين والجمعيات العاملة في مجال الإدماج، لغياب المرجعية القضائية الإنسانية في مرحلة ما بعد الحكم.
المبحث الثالث: المقارنة الفقهية والتحليل القانوني بين النظام الجنائي القائم ومشروع قانون SURE:
مقدمة المبحث
لا تكتسب القيمة التحليلية لأي إصلاح جنائي مشروعيتها الكاملة إلا إذا قورنت نصوصه بالمبادئ السارية قبله، وتم تقييمه من حيث جدته، وحدته، وأثره على النسق القانوني العام. ومن هذا المنطلق، فإن المقارنة بين القانون الجنائي الفرنسي المعمول به، ومشروع التعديلات المقترحة في قانون SURE، تكتسب أهمية مزدوجة: الأولى فقهية، تتصل برصد التحول في المفاهيم العقابية والإجرائية، والثانية وظيفية، تتعلق بقياس مدى احترام المشروع للتوازن بين فعالية الردع وضمانات المحاكمة العادلة.
ويظهر الفحص الأولي أن مشروع القانون لا يعد مجرد تطوير نصي لبعض المواد، بل يكرس فلسفة جديدة ترى أن العدالة يجب أن تكون «سريعة، نافعة، ونافذة»، حتى وإن جاء ذلك على حساب أدوات التفريد، ومبدأ التدريج، ومركزية سلطة القاضي.
وانطلاقا من ذلك، يتناول هذا المبحث المقارنة بين المنظومتين وفق ثلاث زوايا: أولا، من حيث مفهوم العقوبة وفلسفة الردع، ثانيا، من حيث هيكلة الإجراءات وضمانات المحاكمة، وثالثا، من حيث خلفيات الإصلاح ووجهات النظر الفقهية المتعارضة حوله.
أولا: التحول في فلسفة العقوبة من التفريد القضائي إلى التبسيط التنفيذي:
من أبرز أوجه التباين بين القانون الجنائي الفرنسي المعمول به ومشروع قانون SURE، يكمن في الفلسفة التي تسند إلى العقوبة، ليس بوصفها مجرد أداة ردع، بل كأداة تعكس تصور الدولة للعدالة، وموقع الفرد فيها، ودرجة احترام حقوقه وحرياته في مواجهة السلطة.
ففي ظل النصوص المعمول بها، وخاصة منذ الإصلاح الكبير لسنة 1992، تعززت مكانة العقوبة كشكل من أشكال «العدالة الفردية»، التي تمكن القاضي من تفصيل الجزاء وفقا لشخصية الجاني، وخطورة الفعل، وظروف ارتكابه، وحدود إمكانيات الإصلاح. وتمحورت هذه الفلسفة حول مبدأ «تفريد العقوبة» (individualisation de la peine)، الذي يحتل موقعا مركزيا في النظرية الجنائية الفرنسية، كما في الأنظمة المقارنة.
وقد ترجمت هذه الفلسفة في تنوع العقوبات: من السجن إلى الغرامة، ومن الأعمال ذات المنفعة العامة إلى الإقامة الجبرية، ومن المنع من الحقوق إلى برامج التأهيل. كما انعكست على مستوى النصوص الإجرائية، التي أفرزت آليات دقيقة للتدرج في التنفيذ، والسماح بإعادة التكييف، وتعديل أسلوب التنفيذ وفق تطورات شخصية واجتماعية.
لكن مشروع قانون SURE يقوض هذا البناء المفاهيمي، ويقترح، بدلا عنه، فلسفة «التبسيط التنفيذي»، التي تعيد تشكيل العقوبة بوصفها أداة صلبة، محدودة الصيغ، سريعة التطبيق، ذات طبيعة نمطية قابلة للضبط الإداري.
ويظهر هذا التوجه جليا في تقليص صور العقوبات إلى أربع فقط (سجن، غرامة يومية، إشراف قضائي، قيود)، وفي التوسيع الإلزامي لنطاق التنفيذ الفوري، دون تأجيل أو إعادة تكييف، وفي فرض حد أدنى للعقوبة في بعض الجرائم، ما يحول القاضي من منشئ للجزاء إلى منفذ لخيار تشريعي جاهز.
وفي المقارنة بين هذين التصورين، يظهر الفرق الفقهي بشكل واضح:
٭ ففي النموذج القائم، تبنى العدالة على فكرة «الاستحقاق التقديري»، حيث يقدر القاضي ما يستحقه الجاني لا فقط وفق النص، بل أيضا وفق السياق. ويعد هذا أحد تجليات العدالة الإنسانية.
٭ أما في النموذج المقترح، فتغلب فكرة «الملاءمة التنفيذية»، أي أن تكون العقوبة قابلة للتنفيذ الفوري دون الحاجة إلى تفصيل، ما يجعل العملية القضائية أقل مرونة، وأكثر تشابها، وإن بدت أكثر صرامة.
وهذا التحول يحول القاضي من حكم إلى منسق إداري، ويحول العدالة من فعل حكم إلى إجراء تنفيذ.
بل إن هذا التبسيط الشكلي لا ينتج بالضرورة عدالة أكثر فعالية، لأنه يسقط من الاعتبار الفوارق الفردية الدقيقة التي تشكل في غالب الأحيان الفرق بين الإنصاف والعقوبة الظالمة.
ومن جهة أخرى، فإن التوحيد المفرط في صور العقوبات يتناقض مع المعايير الأوروبية المقارنة، كما في النظامين الألماني والإيطالي، اللذين يوسعان من قاعدة الجزاءات لتلائم التعدد الواقعي والاجتماعي للجريمة، ويبقيان سلطة القاضي في الاختيار والتفصيل.
كما أن هذا التحول يهدد التماسك العام للمنظومة الجنائية، حيث أن صلابة العقوبة وسرعة تنفيذها لا تعني دائما فعاليتها. بل يمكن، في بعض السياقات، أن تنتج ارتدادا جنائيا (effet criminogène)، نتيجة لافتقاد الإجراءات إلى الأبعاد التربوية والاجتماعية التي تشكل جوهر «العدالة التصالحية».
ثانيا: إعادة هيكلة الإجراءات الجنائية من المحاكمة العلنية إلى العدالة التفاوضية:
لم يكن مسار العدالة الجنائية الفرنسي مجرد منظومة لإصدار الأحكام، بل كان تقليديا يفهم بوصفه فضاء علنيا لحسم النزاعات الجنائية، يتأسس على محاكمة تراعي عناصر المواجهة، الحضور، العلنية، وحق الدفاع، حيث ينظر إلى الجناية على أنها فعل ضد المجتمع، يتطلب من المحكمة تفسيرا علنيا، يعبر عن ضمير الأمة.
لكن مشروع قانون SURE يسعى إلى إعادة هيكلة هذا النموذج عبر توسيع آليات العدالة التفاوضية، وعلى رأسها آلية الإقرار بالذنب (CRPC)، لتشمل الجرائم الكبرى، بما يمثل تحولا جذريا في فلسفة الإجراءات القضائية.
1. النظام الإجرائي القائم: مركزية العلنية وعلو الوظيفة القضائية:
في النظام المعمول به، وبخاصة في الجنايات، يبنى الإجراء الجنائي على مبدأ “العلنية” (publicité de l’audience)، حيث تقام المحاكمة أمام هيئة تضم قضاة ومحلفين، يمنح الدفاع فيها كامل أدواته، وتمنح الضحية فرصة المشاركة، ويفسح المجال لإبراز الظروف المخففة أو المشددة، ثم تصدر العقوبة بوصفها خلاصة لمواجهة قانونية عادلة.
ويعكس هذا النموذج ما يعرف بـ«العدالة الرمزية»، أي أن العقوبة لا تؤدي فقط وظيفة الردع، بل أيضا وظيفة التعبير العمومي، وترميم النظام القانوني الذي أختل بارتكاب الجريمة. وفي هذا الإطار، لا ينظر إلى السرعة أو التبسيط كغايات مستقلة، بل كأدوات لا تبرر بذاتها التضحية بالضمانات الجوهرية.
2. العدالة التفاوضية في مشروع قانون SURE:
أما في مشروع قانون SURE، فيقترح أن تفتح آلية الإقرار بالذنب لتشمل فئة واسعة من الجنايات، دون المرور بمحكمة الجنايات أو إجراء تحقيق شامل، بشرط اعتراف المتهم، وموافقة الضحية، ومصادقة القاضي على اتفاق مسبق.
وتعد هذه الخطوة، من منظور إجرائي، «خصخصة» جزئية للعدالة الجنائية، إذ تحول الجناية من شأن عام إلى صفقة خاصة بين النيابة والمتهم، في ظل مراقبة قضائية شكلية. وينتج ذلك تراجعا عن مفهوم المحاكمة بوصفها مشهدا تشاركيا يمثل العدالة أمام المجتمع، إلى نموذج مغلق، يدار في مكاتب النيابة، حيث تستبدل العلنية بالفعالية، ويقصى الدفاع من إمكان التأثير الفعلي.
وقد نبه الفقيه Denis Salas [4] إلى خطورة هذا المسار، مؤكدا أن «المحاكمة التفاوضية، مهما بلغت من دقة، لا تعوض طقوس المحاكمة الجنائية، التي تشكل لحظة أخلاقية وقانونية في آن»، مضيفا أن المس بجنايات المجتمع يجب أن يجابه بمنصة علنية، لا بتسوية صامتة.
3. الإخلال بمبدأ المساواة بين المتهمين:
كما أن اعتماد هذا النموذج يفتح الباب أمام تفاوتات خطيرة، إذ يصبح المتهم الذي يمتلك محاميا كفؤا وقادرا على التفاوض، في وضع أفضل من المتهم الذي لا يعرف شروط الإجراء أو لا يعرض عليه. وبالتالي، تكافأ القدرة التفاوضية لا بالضرورة حسن السلوك أو الندم، مما ينتج تفاوتا إجرائيا بين متهمين ارتكبوا الجريمة نفسها.
وتشير دراسة نشرت في مجلة العلوم الجنائية (Revue de science criminelle [10]، 2024)، إلى أن «العدالة التفاوضية، حين لا تضبط، تهدد جوهر مبدأ المساواة أمام القضاء»، وهو ما يثير قلقا بالغا في ظل غياب آليات مراجعة جدية لهذا النوع من الاتفاقات.
4. البعد الدستوري والاتفاقي:
من الناحية الدستورية، فإن المحاكمة التفاوضية الموسعة قد تتعارض مع المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة في تفسير المحكمة الأوروبية التي تشدد على أن «التنازل عن المحاكمة الكاملة يجب أن يتم بحرية، وبوعي، وبحضور فعلي للدفاع»، وهو ما قد لا يتوفر دائما في المسارات الإدارية المعجلة.
وقد سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن أقر في قراره رقم 2012-280 QPC، أن «أي تعديل يمس ضمانات المحاكمة يجب أن يرافق بضمانات معادلة في التوازن»، ما يجعل من الضروري مساءلة مشروع القانون عن مدى توافر هذه المعادلة في آلية الإقرار بالذنب الموسعة.
ثالثا: الخلفيات السياسية والاجتماعية للإصلاح: بين ضغط الشارع وتحديات الردع:
تظهر قراءة مشروع قانون SURE، في أبعاده الفلسفية والتنظيمية، أنه لا يمثل مجرد مراجعة تقنية لأدوات الردع والعقاب، بل هو تجل واضح لاستجابة تشريعية مباشرة لسياق سياسي واجتماعي محتقن، يتسم بتزايد القلق الشعبي من «انفلات العقوبة»، وتراجع ثقة المواطنين في نجاعة المنظومة القضائية، في ظل تكرار بعض الجرائم، خصوصا تلك التي تستهدف ممثلي السلطة العامة.
1. الاستجابة لتصاعد الخطاب الأمني:
منذ العام 2022، تصاعد الخطاب السياسي الموجه نحو ضرورة «استعادة هيبة الدولة»، لا سيما في أعقاب الاعتداءات على رجال الشرطة في الضواحي، والتوترات الاجتماعية في أحياء حضرية فقيرة، والتي كثيرا ما رافقتها اتهامات للقضاء بالتساهل، وللمؤسسات العقابية بالعجز عن التنفيذ.
وقد كان هذا الخطاب حاضرا بقوة في الحملات الانتخابية، وفي تصريحات الوزراء، الذين سعوا إلى استثمار هذا المزاج العام لإبراز صورة الحزم، وربما لاستعادة توازن سياسي داخل حكومة لا تخفي قلقها من صعود التيارات اليمينية والشعبوية.
ويفهم من ذلك أن مشروع القانون لا ينبع فقط من دراسة تقويمية علمية لحالة العقوبات، بل يشكل أيضا أداة سياسية في مواجهة الخطاب الشعبوي، الذي لطالما اتهم القضاء الفرنسي بـ«التراخي» و«البيروقراطية».
2. تأثر الإصلاح بمطالب النقابات الأمنية:
من المؤشرات اللافتة في بلورة مشروع قانون SURE، هو الدور الضاغط الذي مارسته نقابات رجال الأمن (مثل نقابة الشرطة الوطنية Alliance)، والتي طالما دعت إلى تشديد العقوبات، وتعزيز نفاذها، وتقييد سلطة القضاة في منح التخفيف أو السجر، بحجة أن ذلك يضعف من تأثير الردع، ويزيد من التوتر الميداني.
وقد جاءت عدة مقتضيات في المشروع متطابقة بشكل لافت مع مطالب هذه النقابات، مثل: إلغاء الحبس مع وقف التنفيذ، فرض العقوبات الدنيا، وتوسيع الحبس الاحتياطي. وهو ما يطرح تساؤلا مشروعا حول مدى استقلال السلطة التشريعية في بناء سياستها العقابية، بعيدا عن منطق «الاستجابة النقابية».
وفي هذا السياق، نبهت نقابة القضاة (USM [12]) في بيانها إلى أن «العدالة لا يمكن أن تدار بردود الأفعال أو تحت الضغط، بل يجب أن تستند إلى معايير موضوعية وحقوقية، لا إلى إملاءات ظرفية».
3. استثمار الرأي العام وتطويعه:
لا يخفى أن مشروع قانون SURE جاء في لحظة سياسية دقيقة، تسبق الانتخابات التشريعية القادمة، ما يجعل من تبنيه فرصة حكومية لإثبات الجدية في مكافحة الجريمة، واستعادة المبادرة التشريعية من اليمين المتطرف.
وقد أظهرت عدة استطلاعات أن فئة واسعة من المواطنين تعبر عن قلقها من إفلات الجناة من العقاب، ما يعزز من قبول مثل هذه المشاريع، حتى وإن كانت تتعارض مع القيم الليبرالية التقليدية التي طبعت القانون الجنائي الفرنسي.
لكن هذا الاستثمار السياسي يثير، في المقابل، قلقا بالغا لدى الفقهاء والمشتغلين بالقضاء، إذ أن التشريع العقابي، كونه يقيد الحرية، يجب أن يصدر في سياق عقلاني، لا في لحظات الانفعال الجماهيري. وقد أكد الأستاذ Jean-Pierre Marguénaud أن «القانون الجنائي الذي يسن تحت ضغط الرأي العام، يهدد حياد القضاء، ويحول التشريع إلى سلاح انتخابي أكثر منه أداة للعدالة».
4. غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي:
ورغم أن مشروع SURE يقدم بوصفه «إصلاحا شاملا»، فإن العديد من القضاة يعتبرونه «إصلاحا جزئيا»، لأنه يعالج النتائج دون الأسباب، إذ لا يتناول المشاكل البنيوية للنظام العقابي الفرنسي، مثل ضعف الإمكانيات القضائية، نقص القضاة، تكدس الملفات، وغياب سياسة جنائية بديلة حقيقية.
وقد وصف قضاة محكمة باريس العليا المشروع بأنه «مجموعة من المسكنات النصية»، معتبرين أن «تسريع تنفيذ عقوبة غير مدروسة لا ينتج عدالة، بل يفاقم من آثار الظلم المحتمل».
الخاتمة العامة ونتائج الدراسة:
تعد لحظات إصلاح القانون الجنائي، في كل النظم القانونية، اختبارا حقيقيا لمدى نضج السلطة التشريعية، وتوازنها بين منطق الحزم وضوابط الشرعية، بين مطالب الأمن ومقتضيات الحرية، وبين ضغط السياق السياسي واستقلال المرجعية الحقوقية. وفي ضوء هذا الإطار، حاول مشروع قانون العقوبات الفرنسي لسنة 2025، المعروف باسم SURE، أن يقدم تصورا جديدا للسياسة الجنائية، قوامه السرعة، والفعالية، والنفاذ الفوري للعقوبات، عبر إعادة تشكيل بنية العقوبة، وتعديل الإجراءات الجنائية، ضمن ما يوصف بـ«العدالة المنجزة».
لكن الفحص القانوني والفقهي الدقيق لهذا المشروع، يظهر أنه لا يقتصر على إصلاح أدوات التنفيذ، بل يحمل في جوهره تحولا عميقا في الفلسفة العقابية الفرنسية. فبدلا من أن تفهم العدالة بوصفها توازنا بين الفرد والدولة، ومجالا لتفريد الحكم والتأني في النطق، صارت تقدم كمنتج إداري يجب أن ينجز بسرعة وكفاءة، حتى ولو على حساب التمايز بين الحالات، ودور القاضي، وحق الدفاع، ومكانة الضحية.
وقد أبرزت الدراسة عددا من النتائج الجوهرية:
أولا، أن مشروع القانون يتجه بوضوح إلى تقييد السلطة التقديرية للقاضي، سواء في اختيار العقوبة (عبر تقليص صورها إلى أربع فئات نمطية)، أو في تنفيذها (عبر فرض التنفيذ الفوري، وإلغاء الحبس مع وقف التنفيذ في كثير من الحالات)، وهو ما يتعارض مع مبدأ تفريد العقوبة المنصوص عليه في القوانين الفرنسية والدستور.
ثانيا، أن المشروع يعيد تفعيل مفهوم «العقوبات الدنيا»، لا فقط في حالات التكرار، بل حتى في ارتكاب الجريمة لأول مرة في بعض الجرائم، ما يفقد القاضي إمكانية ملاءمة الجزاء للظروف الشخصية والاجتماعية، ويحول الحكم القضائي إلى عملية حسابية لا تقبل التعديل.
ثالثا، أن التعديلات الإجرائية الواردة في المشروع، وعلى رأسها توسيع آلية الإقرار بالذنب لتشمل الجنايات، تقوض مبدأ العلنية، وتضعف من الدور المركزي للقاضي، وتقزم مشاركة الضحية، مما يحول العدالة من عملية مجتمعية إلى إجراء تفاوضي مغلق، لا يخلو من مخاطر الانحراف أو التفاوت.
رابعا، أن إدخال معيار «اضطراب النظام العام» كسبب للحبس الاحتياطي، يمثل تراجعا خطيرا عن قرينة البراءة، ويدخل القاضي في دائرة التأثر بالضغط السياسي أو الإعلامي، بما يتنافى مع المعايير الدستورية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
خامسا، أن التوسيع المفرط لاختصاص المحاكم الجنائية الإقليمية، على حساب محكمة الجنايات وهيئة المحلفين، يضعف المشاركة الشعبية في العدالة، ويقوض الرمزية القضائية التي تميز محاكمة الجنايات، ويفتح الباب أمام عدالة تكنوقراطية لا تتمتع بالقبول الاجتماعي الواسع.
سادسا، أن التقييد المقترح لصلاحيات قاضي تنفيذ العقوبة، يمثل تراجعا عن فلسفة إعادة التأهيل والمرونة، ويهدد فعالية النظام التنفيذي نفسه، إذ يمنع التدرج، ويجبر القضاء على تنفيذ عقوبات ثابتة قد لا تناسب واقع الحال أو مصلحة الإدماج.
وأخيرا، تبين أن الخلفية السياسية والاجتماعية للمشروع، القائمة على الضغط الأمني والمطالب الشعبوية، قد أثرت بعمق على محتوى الإصلاح، مما يفقده صفة التشريع الهادئ والمتوازن، ويحوله إلى أداة استجابة ظرفية، لا إلى مشروع إصلاح بنيوي حقيقي.
بناء عليه، فإن هذا المشروع، وإن كان يقدم بوصفه ضرورة لتحقيق فعالية الردع، إلا أنه يحمل في طياته تهديدا حقيقيا للبنية الحقوقية للعدالة الجنائية، ما يستدعي إعادة النظر فيه من منظور شمولي، يعيد الاعتبار للوظيفة الإنسانية للقضاء، ويوازن بين مقتضيات التنفيذ وضمانات الإنصاف.
قائمة المراجع
1. Jean Pradel [1]، Droit pénal général، Cujas، 22e édition، 2022.
2. Stéphane Detraz [2]، Justice pénale et efficacité، LGDJ، 2021.
3. Antoine Garapon [3]، Bien juger: Essai sur le rituel judiciaire، Odile Jacob، 2016.
4. Denis Salas [4]، La justice dévoyée؟، PUF، 2020.
5. Conseil constitutionnel [5]، Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007.
6. CEDH، Letellier c. France [6]، arrêt du 26 juin 1991.
7. CEDH، Horych c. Pologne [7]، arrêt du 17 avril 2012.
8. Cour de cassation [8]، chambre criminelle، arrêt du 6 novembre 2018.
9. Dominique Raimbourg [9]، Réflexions sur la justice pénale، Dalloz، 2023.
10. Revue de science criminelle [10]، n° 2،2024.
11. Rapport du Conseil supérieur de la magistrature [11]، 2025.
12. USM [12] – Union Syndicale des Magistrats، Communiqués 2025.
13. Projet de loi SURE [13] – Ministère de la Justice، version juillet 2025.