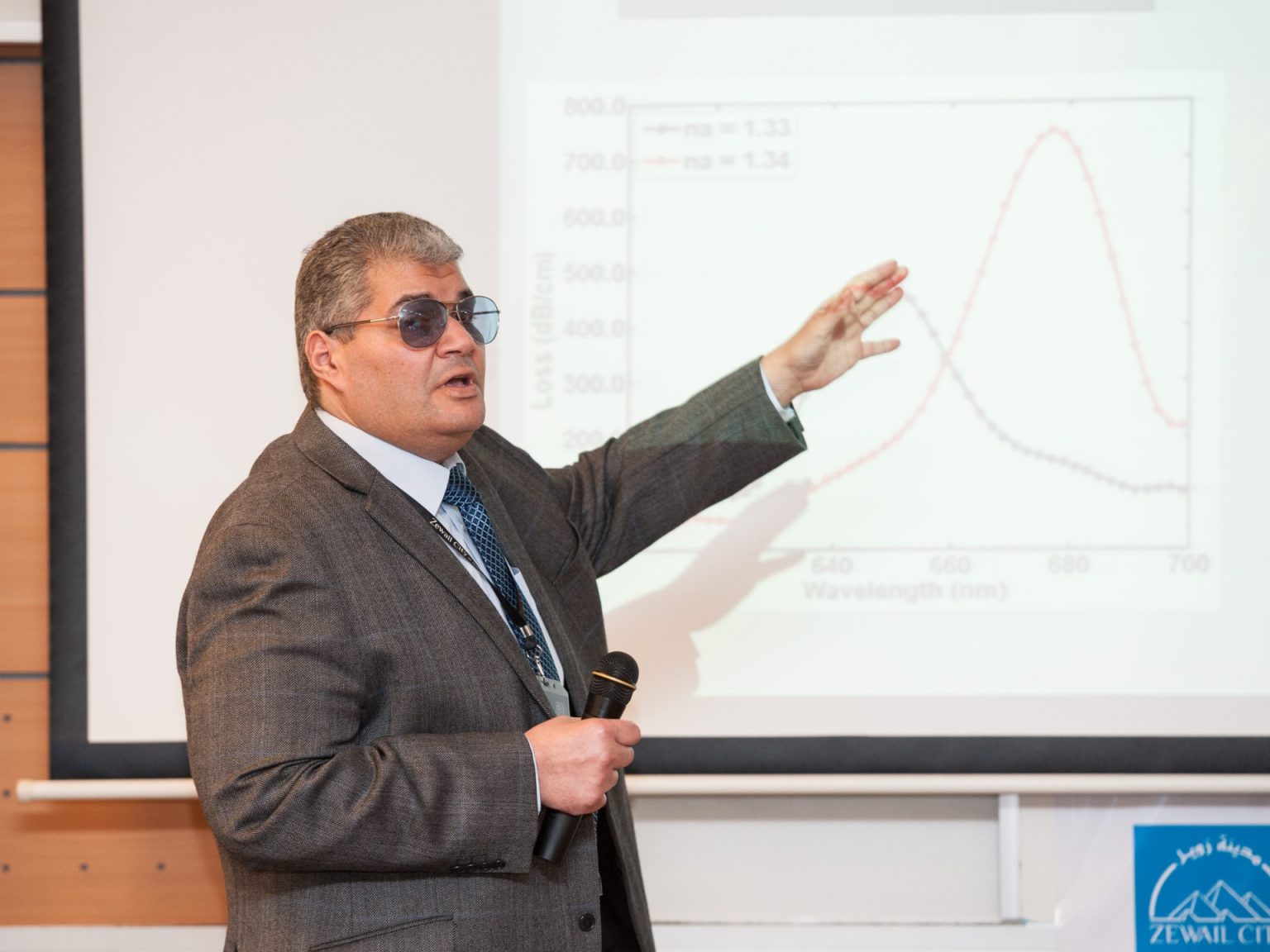اختارت أكبر منظمة مهنية في العالم تسعى لتطوير التكنولوجيا لصالح البشرية، وهي معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بأميركا، البروفيسور المصري صلاح عبية، ضمن العلماء البازين عالميا خلال الثلاثين عاما الماضية في مجال الفوتونيات (الضوئيات) الحاسوبية، وذلك في مقالة حديثة نشرتها بعنوان “العولمة في أبحاث تطوير الضوئيات”.
لم يكن هذا الاختيار للبروفيسور عبية -وهو مدير ومؤسس مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل والرئيس العام للمعاهد البحثية بالمدينة- سوى حلقة في سلسة من الجوائز والتكريمات التي يحصل عليها بشكل دوري، لتكون بمثابة حصاد لرحلة طويلة من الكفاح، نجح خلالها في تجاوز عشرات العراقيل التي تفاجأنا خلال الحوار أن أحدها كان في سن مبكرة عندما كانت بدانة جسمه سببا في تنمر أقرانه، وغذّت معلمة الفصل هذه الحالة بالقسوة البالغة في معاملته جسديا ولفظيا.
ويتذكر عبية -الذي اختاره العالِم المصري الراحل أحمد زويل ليكون أول رئيس للمدينة التي تحمل اسمه- تلك المرحلة القاسية جدا في مسيرته، والتي نجح في تجاوزها بدعم عائلي، وبثقة معلمة أخرى جاءت لتحل محل الأولى التي سافرت مع زوجها للعمل في الخارج، وتلتقط المعلمة الجديدة علامات النبوغ المبكر التي كادت أن تدفنها معلمة لا تحسن التعامل مع الأطفال في هذه السن المبكرة الحرجة.
ويحكي عبية كيف أطلقت تلك المعلمة الجديدة شرارة الانطلاق لرحلة نجاح خاضها بين مصر وبريطانيا، ليختار في النهاية أن يحل برحاله في مدينة زويل مشاركا العالم المصري الراحل أحمد زويل حلم بناء جيل من الشباب المصري قادر على بناء مصر الحديثة بالعلم.
ويتوقف عبية خلال الحوار عند كل محطة من محطات تلك الرحلة الطويلة، محاولا أن يستخلص من تجربته دروسا مستفادة تصلح لتطوير التعليم الأساسي والجامعي، ليس في مصر فقط، ولكن في كل ربوع العالم العربي.. وفيما يلي نص الحوار.
- خلف كل قصة نجاح طريق بالطبع لم يكن ممهدا، فما هي أبرز العراقيل التي نجح الدكتور عبية في تجاوزها؟
أول العراقيل وأخطرها كانت في سن مبكرة، وكادت تنهي قصتي قبل أن تبدأ، حيث تعرضت في أولى سنوات التحاقي بالمدرسة لتنمّر أقراني من الطلاب بسبب بدانة جسمي، ثم جاءت معلمة الفصل لتزيد الطين بلة حيث كانت تعاملني بقسوة بالغة، حتى إنها كانت تواصل ضربي بقطعة الخشب المخروطية التي كانت تحملها، حتى تصاب بالتعب والإرهاق.
- ولماذا كانت تفعل ذلك؟
كنت طفلا فاقدا للثقة بسبب تنمر أقراني، وكان ذلك يجعلني غير قادر على التجاوب مع أسئلتها، وبدلا من أن تحتويني وتعالج الأمر بحكمة، كانت تزيد من أسباب التنمر سببا آخر، وهو أني طفل بدين، ولست متميزا دراسيا.
- وكيف تجاوزت تلك العقبة؟
تجاوزتها بدعم تلك السيدة التي كانت تتحدث معي هاتفيا، وهي شقيقتي الكبرى التي أزعجها حصولي على تقدير متدن في الشهادات الدراسية، فكانت تأتي من منزل الزوجية لتساعدني في استذكار دروسي، وكانت ترفع لوالدي تقريرا بأن مستواي الدراسي على عكس ما يظهر في الشهادات الدراسية، ونصحت والدي باستقدام مدرس خاص في المنزل للتأكد من حقيقة ما توصلتْ إليه، وبالفعل دعم المدرس الخاص الذي استقدمه والدي ما ذهبت إليه شقيقتي الكبرى، وهذا بالطبع منحني بعض من الثقة بالنفس.

- ولماذا استخدمت كلمة “بعض”؟
لأن الثقة الكاملة بالنفس كان مصدرها معلمة أخرى، واسمح لي أن أذكر اسمها لتكريمها؛ كان اسمها “إيمان”، وجاءت تلك المعلمة لتحل محل الأخرى القاسية التي تزوجت وسافرت مع زوجها للعمل خارج مصر، وتزامن ظهور تلك المعلمة مع استعانة أبي بالمدرس الخاص لتقييمي، ولأنها كانت صاحبة وجه بشوش ومريح، نجحت في احتوائي، وتبدل حالي معها تماما، لأتحول من طالب فاشل إلى الطالب رقم “1” على المدرسة، وأعطاني ذلك ثقة كاملة بالنفس، وأصبحت المصدر الذي يلجأ له أقراني من المتنمرين سابقا لتوضيح بعض النقاط الصعبة في الدروس، وبالتالي تجاوزت تلك العقبة التي كادت تقضي على قصتي قبل بدايتها.
- وكأنك عدت لسنوات الطفولة، فقد تباينت ملامح وجهك، بين ضيق شديد وأنت تحكي عن المعلمة القاسية، وفرحة وارتياح وأنت تحكي عن المعلمة صاحبة الوجه البشوش.
لأن تلك المرحلة لا تزال عالقة بتفاصيلها الصغيرة في ذهني، لأنها أهم مراحل الحياة، ومن خلالها تستطيع بناء شخصية سوية قادرة على التعبير عن أفكارها بحرية، أو تهدم الشخصية تماما فتصبح مسخا لا قيمة له.
(ويدخل في نوبة من الضحك قبل أن يقول).. تخيّل؛ لأن تفاصيل تلك المرحلة كانت لا تغادر ذهني، اكتشفتُ نجل تلك المعلمة القاسية -وكان أحد طلابي في كلية الهندسة جامعة المنصورة- من لون عينيه.
(مواصلا الضحك) في أول محاضرة لي معيدا بكلية الهندسة، كان هناك طالب يجلس في المقاعد الأمامية، ومنذ وقعت عيني عليه وجدت أن لون عينيه مختلف ويشبه لون عين تلك المدرسة القاسية.. تخيل لم أنس لون عينيها! فسألته عن مهنة والديه، فعرفت أن والدته هي تلك المعلمة القاسية، وكانت هذه من المفارقات الغريبة، لكني كنت أعامله معاملة طيبة للغاية، ولم أقص عليه تفاصيل ما فعلته والدته معي.
- ربما تكون الظروف قد خدمتك بوجودك في أسرة سعت لحل مشكلتك وحظ جيد أزاح تلك المعلمة القاسية من طريقك، لكن ماذا لو لم تتوفر تلك الظروف لآخرين؟
من أجل ذلك، أؤكد دوما أهمية تلك المرحلة المبكرة، فيجب أن يكون المدرس مؤهلا للتعامل مع الأطفال واكتشاف مشاكلهم، ولا أعني بالتأهيل هنا الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، فكم من الحاصلين على تلك الدرجات ولا يجيدون التعامل مع الأطفال، لكن ما أقصده بالتأهيل هو التدريب الدائم، والذي يساعد المعلم مثلا على اكتشاف أن طالبه يعاني من مشكلة تسمى “الديسلكسيا”.
- وما هي الديسلكسيا؟
“الديسلكسيا” ليست إعاقة، فصاحبها ليست لديه مشكلة في التحصيل، لكن من يعاني منها يكون لديه مشكلة في التعبير المتأخر عن أفكاره، فإذا كان الشخص الطبيعي يحتاج مثلا لخمس دقائق للإجابة على سؤال، سيحتاج من يعاني من “الديسلكسيا” إلى 10 دقائق، وبالتالي سيكون من الغبن ان تمنح مريض “الديسلكسيا” نفس وقت الامتحان الذي تمنحه للطالب العادي، وهذه المشكلة مثلا لا يكتشفها إلا معلم جرى تدريبه، أما إذا لم يكن مدربا فسيسيء التعامل مع الطالب الذي يعاني من تلك الحالة، وقد يتعامل معه بقسوة ويهدم شخصيته تماما، مثلما كانت المعلمة القاسية تفعل معي.
- بالطبع فإن الانطلاقة التي منحتها لك المعلمة ذات الوجه البشوش استمرت معك بعد ذلك.
استمرت والحمد لله، حيث أكرمني الله في سنوات الدراسة الإعدادية بأساتذة أجلاء، واسمح لي أن أذكر اسم أحدهم وهو مدرس الرياضيات الأستاذ عادل السواح، الذي دائما ما كان يقول لي إنه لا بد لي أن التحق إما بكلية الهندسة أو كلية العلوم قسم الرياضيات، وأذكر أن هذا المدرس من فرط إعجابه بقدراتي، كان يحضّر لي مسائل رياضية من كتب قديمة، ويطلب مني حلها.
وتكرر الأمر نفسه في المرحلة الثانوية التي اجتزتها بتفوق كبير، حيث كنت الأول على منطقة شربين بمحافظة الدقهلية بمصر، وكانت المفاضلة بين الالتحاق بكلية العلوم قسم الرياضيات أو كلية الهندسة، لكن وقع الاختيار على الهندسة بعد زيارة قمت بها إلى الكلية قبل كتابة رغبات الالتحاق بالكليات، فقد وجدت خلالها أن المناهج تتوافق مع ما أحب وأعشق، لاسيما قي قسم الإلكترونيات والاتصالات الذي تخصصت فيه.
وما حدث معي في المرحلة الإعدادية والثانوية من اهتمام الأساتذة، حدث معي في الكلية، حيث أكرمني الله برعايه أساتذتي الدكاترة حمدي الميقاتي وعبد الفتاح إبراهيم ورشيد العوضي، فما كان يميز هؤلاء أنهم كانوا حريصين ليس فقط على إعطاء الطلاب ما يملكون من علم، ولكنهم يعطونه أكثر مما يملكون.
ما زلت أذكر أستاذي حمدي الميقاتي أمد الله في عمره، وهو يقوم بنفسه بتصوير بعض المقالات العلمية من مجلات عالمية ليطلب مني قراءتها ومناقشته فيها، وهذا الأمر خارج المنهج الدراسي تماما، لكنه كان يريد أن تتفتح مداركي على ما يحدث في العالم.
- ولماذا وقع اختياره عليك من بين الطلاب ليمنحك هذه الميزة؟
كان من نبل هذا الأستاذ الجامعي أنه يحرص على إعطاء التمارين التطبيقية على المحاضرة بنفسه، وهي مهمة يتم عادة إسنادها للمعيدين، وفي إحدى المحاضرات كتب تمرينا ولم يستكمله، طالبا منا استكماله، ليرى ما فعلنا في المحاضرة التالية، فما كان مني إلا أن قمت بحله ببداية مختلفة عن تلك التي بدأها، ومن يومها حظيت برعايته واهتمامه. وكان من نتيجة هذه الرعاية أن استكملت دراستي العليا معه بعد اجتيازي البكالوريوس بتفوق، حيث كان مشرفي في الماجستير.
وعندما بدأت أبحث عن مقترح للدكتوراه لاستكمال دراستي العليا معه، فوجئت به يرفض رفضا قاطعا ويقول: “هو أنت ستظل تتعلم طيلة حياتك من حمدي المقياتي فقط، يجب أن تسافر للحصول على الدكتوراه من الخارج، وظل يسعى بنفسه كي أحصل على فرصة للسفر”، فهذا الرجل كمن فتح لي باب قصر كبير، بينما كنت أريد أن يفتح لي باب غرفة صغيرة.
- ولماذا وصفت السفر للخارج بأنه “كمن فتح لك باب قصر كبير”؟
قيمة السفر لم تكن في الحصول على الدكتوراه، فهي تمثل نسبة 5% فقط من الأهمية، لكن النسبة الأكبر -وهي 95%- تتعلق بالفوائد الكبيرة التي تحصل عليها، بداية من لغتي الإنجليزية التي تطورت بشكل كبير، ومرورا بالاقتراب من طرق التدريس المتطورة، وانتهاء بالدرس الأهم وهو كيفية خلق الربط بين البحث العلمي والصناعة، فقد شاهدت كيف تكون العلاقة بينهما والتي تسمح للبحث العلمي بالعمل على مشاكل الصناعة، والحصول على أفكار جديدة لتطوير الإنتاج البحثي بشكل يخدم الصناعة، وبالتالي يشعر الباحث حينها بأن لعمله قيمة ومردودا.
وكل ذلك كان سببه الدكتور حمدي الميقاتي الذي كان يسعى لي من أجل السفر، حتى أعود وأساهم في تطوير مناخ البحث العلمي في مصر، فهؤلاء الأساتذة كانوا يمارسون الوطنية بأفعالهم، وليس بالأقوال الجوفاء.
- طيلة حديثك عن أستاذك حمدي الميقاتي، أشعر بكم الحب والتقدير الذي تكنه له، وأنا أتساءل: لماذا لم يعد لدينا مثل هؤلاء الأساتذة؟
داخل أي إنسان صراع بين القيمة الحقيقية والسعر، وللأسف لأن السعر أصبح ينتصر على القيمة الحقيقية، لم يعد لدينا أساتذة أجلاء مثل حمدي الميقاتي.
للأسف يغضب مني الكثيرون عندما أحاول تطبيق ما أؤمن به من قيم، حيث أرفض أحيانا مناقشة رسائل ماجستير عندما أرى أنها لا ترقى لأن تكون رسالة علمية، وأرفض أي دعوات على الغداء أو العشاء من قبل الباحثين الذين أناقشهم، وهذا يغضب كثيرين، لأن السعر أصبح هو المسيطر وليس القيمة.
فأنا ثروتي الحقيقية ليست أموالا في البنوك، لكنها في القيمة التي تتمثل في 150 طالبا أشرفت عليهم في الماجستير والدكتوراه، وهم منتشرون في مصر وباكستان وكندا وأميركا وأفريقيا.
- وما السبب في سيطرة السعر على القيمة؟
خليط من أزمات اقتصادية ومشاكل اجتماعية، جعلت الأهم هو الحصول على الشهادة وليس ما ستفيد به مجتمعك من العلم الذي تعلمته، وتغيير ذلك يحتاج لثورة في الأفكار والسلوك، وهذا يحتاج لوقت طويل.
- أثرت نقطة هامة عند حديثك عن الدروس المستفادة من رحلة السفر، وهي الاطلاع على آليات التواصل بين البحث العلمي والصناعة، فهل يمكن نقل تلك التجربة للعالم العربي؟
دعنا في البداية نتحدث عن أصل المشكلة، وهي أن هناك خللا في أداء الجامعة لدورها، فالجامعة مكان لإنتاج المعرفة ونقلها، والمقصود بالإنتاج هو الأبحاث والدراسات، أما نقل المعرفة فلا يتحقق منه سوى عنصر واحد فقط وهو نقلها للطلاب، ولكن لا يحدث نقل من الجامعة إلى المجتمع، وأعني هنا المجتمع الخاص بمجال التخصص، فالهندسة تنقل المعرفة للمجتمع الصناعي، والزراعة للمجتمع الزراعي، والتجارة تنقله للمجتمع التجاري، وهكذا.
وليس أمامنا من حل لهذه المشكلة سوى نقل التجربة الغربية، والتي تقوم على وجود ما يعرف بـ”وادي نقل المعرفة” أو “وادي التكنولوجيا” الخاص بالجامعة، ويكون هناك تجمع للشركات في محيط الجامعة أو القريبة منها تعرف باسم “وادي الشركات الصناعية”، وهي عبارة عن مكاتب ممثلة للشركات.
ومثلما تبدأ العلاقة بين الشاب والفتاة بالتعارف ثم الخطبة والزواج، يحدث ذلك بين هذين المكونين، حيث يجري من حين لآخر تنظيم ورش عمل بين الباحثين ووادي الشركات الصناعية، يتعرف فيها الباحثون على مشاكل الصناعة، وتعرف الصناعة ماذا يفعل الباحثون، ثم تتطور العلاقة، فتقوم الشركات الموجودة بوادي الشركات بفتح مكاتب لها داخل الجامعة، مما يسهل من عملية التواصل بين الجانبين، ثم تتطور العلاقة أكثر وأكثر، فتشارك الشركات في وضع البرامج الدراسية من خلال وجود ممثلين لها في مجالس الكليات، وهذا يجعل تلك البرامج تميل أكثر نحو متطلبات سوق العمل، وتأخذ العلاقة شكلا أكثر تطورا عندما يحصل الطلاب مثلا في السنة الثالثة على فرصة قضاء فصل دراسي في المصانع، وهذا من شأنه أن يحقق عدة مزايا، أولها أن الطالب يحصل على مقابل مادي ويعود للجامعة وهو متسلح بالفكر الصناعي، ويستطيع التقاط فكرة يمكن تنفيذها في مشروع التخرج، والأهم من ذلك أنه يضمن فرصة عمل، وبالتالي تحقق الجامعة دورها في نهضة المجتمع بإتاحة خريج يحصل على فرصة عمل ويفيد المجتمع ولا يمثل عبئا عليه.
للأسف أصبح خريج الجامعة يمثل عبئا على المجتمع، وكان الرئيس المصري قد تساءل في إحدى خطاباته عن الإضافة التي يقدمها خريجو الكليات الإنسانية والاجتماعية للمجتمع. استمعت لهذا الخطاب، وما كان يقصده الرئيس أن هذه الكليات يجب أن تكون أكثر ارتباطا في مناهجها باحتياجات المجتمع.
- وماذا يمكن أن تقدم دراسة الفلسفة مثلا سوى أنها تؤهل خريجا ليصبح مدرسا للفلسفة، لذلك فإن أغلبهم لا يعملون، أو يعملون أعمالا لا علاقة لها بمجال دراستهم؟
من الجيد أنك أشرت لهذا المثال، فالمشكلة ليست في دراسة الفلسفة ولكن فيما ندرّسه للطلاب، فالمناهج تؤهل الطلاب فقط ليصبحوا مدرسي فلسفة، ولكن لو جرى التعامل مع الفلسفة بشكل أوسع فيمكن أن يشارك خريجو هذا التخصص في وضع فلسفة المؤسسات، ويصبحوا قادة داخل تلك المؤسسات.
وهناك مثال آخر لأحد العلوم الإنسانية وهو علم الاجتماع، ففي الخارج يتعين عند التقديم لأي مشروع بحثي أن يُذكر مدى تأثيره في المجتمع، وأنا كباحث في الهندسة لن أستطيع فعل ذلك دون دعم من متخصص في علم الاجتماع، إذن فالمشكلة فيما ندرّسه للطلاب وليس في التخصص نفسه.
- ونحن نسير معك في محطات حياتك، نتوقف عند محطة مدينة زويل.. كيف انتقلت لتلك المحطة؟
بعد الحصول على الدكتوراه في 1999 من بريطانيا عدت لمصر، ولم استمر سوى ثلاثة أشهر، حيث لم تكن الأجواء مشجعة، ويكفي أن أقول لك إن الكلية عجزت عن توفير جهاز حاسب آلي يساعدني في العمل بسبب عدم وجود ميزانية، في حين أنه عندما علمتْ أن مسؤولا كبيرا سيزور الكلية فُتحت الخزائن وخرجت الأموال، وقد أصابني ذلك بالإحباط، وتزامن ذلك مع رسالة تلقيتها عبر البريد الإلكتروني من مشرفي في الدكتوراه يطلب مني العودة لثلاثة شهور لأشاركة في مشروع بحثي يتقاطع مع أبحاث نفذتُها خلال الدكتوراه، فقلت لنفسي إنها فرصة جيدة للخروج من حالة الإحباط، وبالفعل سافرت، غير أن تلك الرحلة دامت 15 عاما، وانتهت عندما طلبني الدكتور أحمد زويل في 2012 للعمل معه، حيث أسست مركز الفوتونيات والمواد الذكية الذي أشرف برئاسته إلى الآن، كما قام الدكتور زويل لاحقا في سبتمبر/ أيلول 2012 بتعييني رئيسا للمعاهد البحثية، وبعدها بثلاث شهور رئيسا لمدينة زويل ونائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- من المؤكد أنك اقتربت كثيرا خلال تلك الفترة من الدكتور زويل، فهل تستطيع تلخيص أهم الجوانب الهامة من شخصيته؟
قصتي مع الدكتورة زويل تحولت من علاقة عمل إلى صداقة، وأستطيع التأكيد أنه على عكس ما يبدو للبعض من أنه شخص يبدو متعاليا، فقد كان شخصا بسيطا للغاية، لكنه يتحول لإنسان مختلف في بعض المواقف.
فمثلا كنا نتناول طعام العشاء في مطعم، فجاءه رجل بطريقة غير حضارية متسائلا عن مشكلة كانت قائمة بين مدينة زويل وجامعة النيل، فما كان من الدكتور زويل إلا أن أحرجه قائلا إنه “ليس المكان المناسب لمناقشة هذا الأمر”، ولكن في مرة أخرى التقط الدكتور زويل -وكان بارعا في قراءه الوجه- رغبة أحد العمال في التقاط صورة معه، فاستدعاه وسأله: هل تريد التقاط صورة معي؟.. فعندما أجاب الرجل بأنه يريد لكنه كان محرجا من الاقتراب منه، طلب مني الدكتور زويل التقاط الصورة التي تجمعه بهذا العامل البسيط.
وعلى مستوى العمل، كان يهتم بأدق التفاصيل، وأذكر أنه اتصل بي ذات مرة يشكو من مستوى ضعف اللغة العربية لدى طالب أرسل له رسالة باللغة العربية، فقادنا النقاش إلى أن تدريس مادة تاريخ العلم باللغة العربية للطلاب قد يكون حلا للمشكلة.
- بعد وفاة الدكتور زويل، هل يسير مشروعه على نفس الخط الذي رسمه من حيث خلق الرابط بين البحث العلمي والصناعة؟
لدينا في مدينة زويل أحد المكونات الموجودة بالخارج والتي حدثتك عنها، وهي مكون وادي العلوم والتكنولوجيا الذي يهدف إلى التعاون والشراكة مع الصناعة، ولكن تفعيله يتعلق بمشاكل تعاني منها الصناعة حاليا بسبب أزمة توفير العملة الصعبة التي أثرت في عدم قدرة المصانع على توفير مكونات التصنيع، وتسعى معظمها إلى عدم التوسع، لأن شغلها الشغل هو البقاء في السوق حتى ولو بهامش ربح بسيط، وبالطبع هذه الظروف ليست مواتية للاستثمار في أفكار جديدة.
ولكن الأمر الإيجابي أن هذا التوجه الذي أرساه الدكتور زويل عبر المدينة، أصبح له تأثيرات غير مباشرة، فبدأت بعض الجامعات تؤسس كيانات شبيهة بوادي العلوم والتكنولوجيا، وبدأ بعض أساتذة الجامعات يفكرون بشكل مختلف، حيث دشن أساتذة بجامعة القاهرة -لى حد علمي- شركة برمجيات نجحت في بيع أحد البرمجيات لشركة “إنتل”، كما أُقر قانون حوافز الابتكار، وفي انتظار تفعيله بإصدار اللائحة التنفيذية، وهذا القانون سينظم تأسيس الجامعات للشركات.
- على مستوى مركز الفوتونيات والمواد الذكية الذي ترأسه منذ تأسيس المدينة، ما هي أبرز الإنجازات التي تعتز بها؟
بداية لا بد من توضيح الفارق بين مجال الإلكترونيات والفوتونيات، فالأول مجال ناضج جدا منذ الستينيات، وهذا يجعل كلفة التصنيع أقل، بينما مجال الفوتونيات لا يتعدى عمره الـ30 عاما ولا يزال بحاجة إلى فهم، لذلك فإن عملنا يبدأ من أول دراسة تعامل الضوء مع المادة بشكل نظري، وصولا إلى التطبيقات.
وفي مركز الفوتونيات بمدينة زويل، نحن من المراكز المعدودة التي تعمل على إنتاج الـ”سوفت وير” الخاص بالتجارب التي ستجري معمليا، بمعني أني لو أردت مثلا العمل على نظام يعمل على تقسيم الأطوال الموجية في عده قنوات من أجل إنشاء نظام متعدد القنوات للاتصال، فينبغي أن أقوم بتنفيذ ذلك على جهاز حاسوب قبل الانطلاق للمعمل، ونحن نقوم بتطوير برامج “سوفت وير” لهذه الأبحاث وغيرها، وهذا من شأنه أن يرفع من معدلات النجاح عند الانتقال بالتجارب إلى النطاق المعملي، وقد اشتهرنا على مستوى العالم بهذا النشاط.
وعلى الجانب التطبيقي حققنا نجاحات متعددة في تطبيقات الاتصالات الضوئية واسعة المدى، والتشفير في الفاير باستخدام الترابط الفوتوني، كما عملنا على تطوير الخلايا الشمسية والمستشعرات الضوئية ذات التطبيقات الطبية والبيئية، ومنها مستشعِر يقيس نسبة الجلوكوز، ومستشعر يتنبأ بالتلوث في مياه النهر.
وحصل الباحثون بالمركز ورئيسه على 35 جائزة ما بين محلية وإقليمية ودولية، كان آخرها ذكر اسمي في مقال معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بأميركا ضمن أبرز علماء الفوتونيات في العالم.
- رغم هذه الإنجازات والجوائز، لا يبدو لي أنك سعيد؟
الباحث دوما يأمل في الأحسن والأفضل، لأنه لو وصل لمرحلة الرضاء الكامل سيتوقف عن العمل، فدائما ما يكون بداخل الباحث أسئلة بلا إجابات، وطالما أن عقله مشغول بها سيصلك هذا الإحساس.
- رغم معرفتي بأن هذه الإجابة دبلوماسية، دعني أختم حواري معك بسؤال أرجو أن تجيب عليه بصراحة، وهو: هل ندمت على الاستجابة لدعوة الدكتور زويل بالعودة للعمل في مصر؟
الإجابة بكل صراحة “الخيرة فيما اختاره الله”.
- دعني أسأل السؤال بصيغة أخرى، لنفترض أن جامعة أكسفورد أو كامبردج تواصلتا معك وطلبتا منك العمل معهما، هل تترك مدينة زويل؟
لن أترك المدينة لثلاثة أسباب:
- أولا: السفر ليس بعيدا عني إن أردت ذلك، فأنا أستاذ فخري منذ سبع سنوات بجامعة نوتنغهام ببريطانيا، وهي واحدة من أفضل عشر جامعات في بريطانيا، وإن طلبت منهم السفر للعمل هناك سيرحبوا كثيرا بذلك.
- ثانيا: أنه وبمنتهى التواضع، فإن إنتاجي البحثي من داخل مصر كما وكيفا، لا أريد أن أقول إنه أفضل، لكنه لا يقل عن إنتاج قادة المجوعات البحثية في مجال الفوتونيات بتلك الجامعات المهمة. مش عايز أقلولك أحسن، في نفس صف قادة المجموعات البحثية.
- ثالثا: حصلت على كافة الجوائز والتكريمات وأنا أعمل في مصر، ومنها أني رئيس لتحرير دورية متخصصة في الضوئيات الكمية تصدر عن دار “سبرنغر نيتشر” الشهيرة، وهذا تكريم كبير.
والخلاصة أن الخير يأتيك في المكان الذي توجد فيه، بشرط العمل في هذا المكان بجد واجتهاد وإخلاص.
- ألا تدفعك ضغوط الحياة للتفكير بشكل مادي، فتسعى لفرص ربما تكون أكثر نفعا من الناحية المادية؟
حدثتك في بداية حوارنا عن صراع القيمة والسعر الذي يثور داخل كل إنسان، وأنا حسمت الصراع داخلي لصالح القيمة، ولا أدعي البطولة، فربما ساعدني في ذلك أن التزاماتي المادية محدودة، فلم يرزقني الله بأطفال، ولا توجد عندي مسؤوليات سوى الإنفاق على زوجتي.
- دعنا من الماديات، فقد تكون الحياة في الغرب أسهل في أمور أخرى؟
الحياة في الغرب ليست مثالية، فالهدف الذي يسعى إليه الجميع هو كيف يكون لديه ثروة كبيرة، لكن هناك قانون يضبط العلاقات، فمن حقك أن تسعى للثروة لكن بما لا يخالف القانون، وهذا هو الفارق الكبير بيننا وبينهم.
وسأعود لما قلته في البداية: يعني مثلا هناك في الغرب أعراف أكاديمية تُحترم، فلا يمكن في ظل وجودها تمرير بعض السلوكيات التي تحدث عندنا، مثل أن يَقبل أستاذ جامعي دعوة على عشاء من طالب سيناقش رسالة الماجستير الخاصة به.